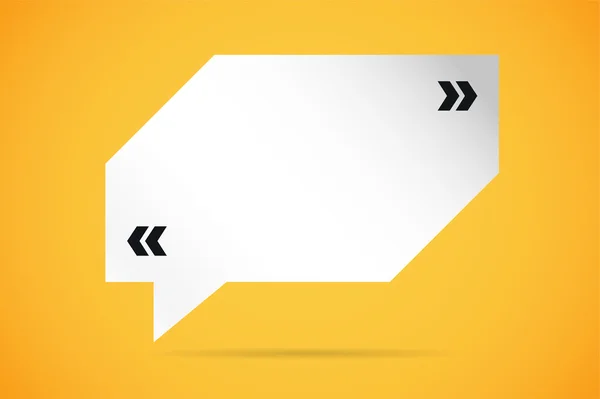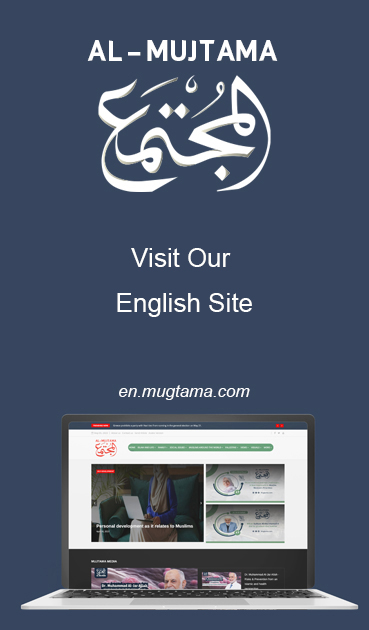الامتحانات على الأبواب.. الأستاذ علي الطنطاوي يقترح أسلوباً جديداً للتعليم

النهضة المرتجاة لأمتنا .. مشروطة بتغيير نظم التعليم فيها.. من البداية الى النهاية.. ولن تقوم نهضة حقيقية إلا بتغيير "عقلية" الإنسان .. ولن تتغير عقلية الإنسان إلا بتجديد أساليب التعليم .. وتحديث طرائقه دوما ... ونظم التعليم الجامدة في بلادنا العربية - الإسلامية .. سبب جوهري من أسباب التخلف العقلي والثقافي والحضاري.
ومما يرهص بالبشرى أن الإحساس بهذا الوضع المعوق يتزايد .. يوما بعد يوم، ففي مصر -ومعظم مناهج التعليم في البلاد العربية منقولة عنها- دعوة تنادي بانقلاب سلمي شامل في نظم التعليم
وفي الكويت مؤتمر لإصلاح مناهج التعليم، ومنذ أربعة أيام قامت في لبنان مظاهرات طلابية أدت إلى تعطيل الدراسة في بعض المعاهد الثانوية تطالب بإدخال تحسينات في مناهج التعليم، وفي المغرب العربي مؤتمرات ودراسات تستهدف تغيير وترقية نظم التعليم.
إن أساليب التعليم الراهنة ما برحت تقود إلى:
1- إطالة فترة التخلف الصناعي والعلمي على مستوى الأمة كلها.
2- إيقاع طلبة العلم -كل عام- في حرج، وبلبلة، وتوتر ومخاوف.. لأنها -أي أساليب التعليم الحالية- أقرب إلى إحراج الطلبة وتحديهم منها إلى الاختبار العلمي الباني للشخصية المكون للعقلية المبتكرة المبدعة.
وهذه مقالة حسنة للأستاذ الفاضل على الطنطاوي كتبها منذ فترة غير قصيرة .. يقترح فيها أسلوبا جديدا للتعليم، والمجتمع إذ تستأذن الأستاذ في نشر هذه المقالة تنادي رجالات التربية والتعليم وتدعوهم إلى التفكير الجدي في هذه القضية الكبيرة والحية.
إن الامتحانات على الأبواب وما من مرب .. معلم مخلص إلا ويعلم مدى العذاب الذي يتعرض له الطلبة بين يدي الامتحانات وخلالها، كما يعلم أن التغيير أمر ممكن.. وميسور وإنما جعلت أساليب التعليم من أجل الإنسان، ولم يجعل الإنسان من أجل اساليب التعليم.
لي أخ كان كلما غشى المدرسة الثانوية رق جسمه ونحل، وعراه ذبول، فأعفيته منها وأبقيته في الدار سنوات ثلاثا لم ألزمه فيها مطالعة شيء من دروس المدرسة، وإنما كنت أدله على بعض كتب الأدب والتاريخ مما لا يثقل عليه ولا ينال من صحته، وما تجزل وتعظم المنفعة به، وقرأ فيما قرأ تاريخ الطبري كله والأغاني.. فلما أزف موعد امتحان الكفاءة منذ سنتين قلت له: لو دخلت مع رفاقك فلعل الله يكتب لك النجاح فأطاعني واستعد للامتحان شهرًا واحدًا ثم دخله فكان من الناجحين، على رغم أن الناجحين في تلك السنة كانوا دون الثلث، وعاد إلى ما كان عليه، حتى كان امتحان الشهادة الثانوية (البكالوريا) هذه السنة، فدخله كما دخل الأول ونجح فيه أيضا
هذا النجاح الغريب دفعني إلى التفكير في الموضوع الذي اكتبه اليوم، وجعلني أسال نفسي فأطيل سؤالها، ألا يمكن أن نسهل للطلاب هذه الدراسة؟
وإذا كانت هذه الغاية وهي شهادة الكفاءة (والصحيح أن تسمى شهادة الكفاية) تُدرك بمسيرة شهر واحد في طريق سهل لاحب، فعلام نمشي إليها ثلاث سنين في طريق صعبة معوجة من ينقطع فيها أكثر ممن يبلغ آخرها؟
أليس لنا بد من أن تضيع زهرة شباب أبنائنا في المدرسة لتعلمهم ما لا يكاد ينفعهم في حيواتهم، إذا هم خرجوا منها، ولم يقدروا أن يشتغلوا بعده بما يشتغل به العامل الجاهل من أعمال اليد، وأشغال السوق؟ ألا يمكن أن نعلم كل طالب ما ينتفع بـه ويميل إليه، ونعفيه من علوم يكرهها، ولا يعتقد فائدتها له في حياته؟ فقالت النفس: لقد أقمت بناءك على غير أساس، وجعلت من هذه الشاذة قاعدة، وأصَّلت عليها أصلًا، إن أخاك هذا وإن أخذ الشهادة فليس له علم من درس يومًا بيوم، وسار على الجادة خطوة فخطوة، ولم يقفز من فوق الأسطحة، ولم يتسور الجدران، وهذه العلوم كلها لازمة لا استغناء عنها، وأسلوب التعليم صالح لا داعي لتبديله.
فرجعتني والله إلى الشك، وكدت أدع الموضوع، ثم فكرت فرأت أن لكل عمل نتيجة، ولكل مسير غاية، والغاية في المدرسة؛ إمَّا أن تكون الشهادة، أو العلم، أو الإعداد لخوض لجة الحياة والنضال عليها.
أما الشهادة فلا بحث فيها؛ لأنها عرض لا جوهر، ووسيلة لغيرها لا يصح الوقوف عليهــا، ولا القناعة بها، وهي بعد عادلة، وقد تكون شهادة زور تعطى لغير أهلها، وتمنح من ليس من مستحقيها.
وما ينفع الفقير المفلس أن يشهد له الناس جميعًا بأنه الغني ذو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ أما العلم فاسألوا المتعلمين ماذا بقي لهم من دروس الثانوية، بل تعالوا أحدثكم ما جربته بنفسي، وما شاهدت عليه تلاميذي، ولقد كنت في دراستي الثانوية مجليًّا دائمًا أو مصليًا، ولم أكن فمسكلًا، ولقد اشتغلت بالتعليم -الأولي والابتدائي والثانوي، الأهلي، والرسمي، والديني- أربع عشرة سنة، قبل أن آتي القضاء في مدارس الشام والعراق ولبنان، وعرفت الآلاف من الطلاب، وأقل ما أستفيده من هذا أني إذا تكلمت أتكلم عن خبرة واطلاع، أقول: إني وجدت بالتجربة أنه لم يبق عندي الآن مما أمضيت في تعلمه السنين الطوال، إلا ما كان طبعي منصرفًا إليه من علوم الدين، واللسان، والتاريخ، والفلسفة، وما عدا ذلك من العلوم الرياضية والطبيعية (لا الطبعية كما يقول بعضهم)، فلا أكاد أعرف منه الآن إلا أشياء عامة جدًّا، أما التفاصيل والدقائق وأعيان المسائل فقد نسيتها كلها، ولو سئلت عما أعرفه من المثلثات (مثلًا) لأجبت: إني لا أعرف إلا شيئًا اسمه الجيب والتجيب (تمام الجيب) والمماس، لا أعرف ما هو على التحقيق، حتى موضوع العلم على وجه التحديد فقد نسيته، مع أن علامتي في السنة التي قرأنا فيها المثلثات كانت تسعًا من عشر، وكنت المجلي (الأول) في صفي (أو فصلي) أما الكيمياء العضوية فلا أعرف منها إلا شيئًا اسمه (الميتان) وتركيبه جزء من الفحم، وأربعة من مولد الماء أو الهيدروجين، وقد درست جغرافية بلاد الدنيا الطبيعية والسياسية والاقتصادية، وكنت مع ذلك كلما سمعت باسم مدينة جديدة يأتي في أخبار الحرب أجدني أجهل مكانها، وأذهب فأسأل عنها الكتب والمصورات، أستوي في ذلك أنا ومن لم يقرأ الجغرافيا قط، وكل من عرفت من الطلاب هذه حالهم لا يستقر في رءوسهم إلا ما يختصون به أنفسهم، وإلا خلاصات موجزة، أفما كان خيرًا لهم لو أقرأناهم هذه الخلاصات في الأصل؟ ولست أقول: دعوا هذه العلوم لا تقرئوها التلاميذ، ولكن أقول: إن هذا الخلط بين العلوم الكثيرة يؤدي إلى إضاعتها كلها، وهذا سر ما نشكوه من ضعف الطلاب في مصر، والشام، والعراق في اللغة، وهي أداة العلم كله، وما نلمسه من عقم القرائح، وفقد المخترع والباحث، ولو أنا رجعنا إلى طريقة أجدادنا الذين كانوا يتعلمون علمين أو ثلاثة، فإذا أحسنوها شرعوا بغيرها لكان أجدى علينا. فمدارسنا إذن لا توصل إلى الغاية العلمية النظرية، فلننظر إلى الغاية العملية هل تبلغنا إياها؟ هل تعد مدارسنا التلاميذ إعدادًا جيدًا للنجاح في الحياة، وضمان الكسب الطيب والعيش الرغد، مع الخلق القويم والإيمان الديني والقومي؟
الجواب مشاهد ملموس هو أن مدارسنا لا (تكاد) تخرج اليوم إلا أطباء، أو محامين، أو موظفين، أما الوظائف فعددها محدود لا يمكن أن يتسع لكل المتعلمين، ولا ينبغي أن يتسع لهم، أما الأطباء والمحامون في دمشق -مثلًا- فقد صاروا من الآن أكثر من اللازم بكثير، وغدا جُلهم يقتنع بالكسب القليل، أما التجارة والزراعة وسائر طرق الرزق فإن أكثر أهلها أو كلهم، ممن لم تخرجهم المدارس، بل خرجوا أنفسهم في مدرسة الحياة الكبرى، ولا نستطيع أن نغلو فنقول بأن خريجي المدارس يمتازون من الناس بأخلاقهم الشخصية والاجتماعية، أو أن المدارس جعلتهم طبقة مختارة ممتازة من طبقات الشعب، بل إنهم كغيرهم من الناس؛ منهم الصالح، ومنهم الفاسد، ومنهم مَن هو بين ذلك.
والسبب في هذا كله أنَّ نظام التعليم في بلادنا كالبيت الخرب، المختل الهندسة، الذي لا يفتأ أصحابه يتعهدونه بالترميم والإصلاح، ولكنهم لا يجرؤون على هدمه من أساسه، وبنائه من جديد على هندسة صالحة، ونمط صحي نافع، أننا نحبس التلاميذ ست سنين للدراسة الثانوية، ونحشو رؤوسهم بمعلومات أكثرها لا ينفع في الحياة، وماذا لعمري استفدت أنا من دراسة المثلثات والهندسة النظرية، و«حفظ» معادلات الكيمياء، وقوانين الفيزياء في القضاء أو في تدريس الأدب أو في فن الكتابة؟ وتلك هي أعمالي في حياتي؟ سيقول قائل، ومن كان يدري أنك ستكون أديبًا أو قاضياً، إنما كان في الإمكان أن تكون مهندسًا أو صيدليًا؟ بلى، ولكن الدراسة العالية حددت طريقي في الحياة، فلماذا لم أحدده قبل ذلك بسنوات؟ هذه هي المسألة، كما يقول شكسبير: إن الدراسة العالية هي المقصودة بالذات، وما قبلها ثقافة عامة، هي بمكان المقدمة إليها والتمهيد لها، أفلا يستطيع الشاب الواعي دراسة الحقوق مثلًا، من غير إحاطة بدقائق الكيمياء والفيزياء والرياضيات؟ أو لا يجزئه ويكفيه أن يعرف عنها الشيء المجمل المختصر؟ وطالب الطب هل يستحيل عليه من غير معرفته بعلل الشعر واختلافات الكوفيين والبصريين؟ لقد شاهدنا محامين بارعين وقضاة لا يعرفون شيئًا من المشتقات ولا تحول التابع، ولا صفات البروم، وشاهدنا أطباء كبارًا استطاعوا أن يعملوا عمليات في شق بطن وفتح الجمجمة، على جهلهم الموازنة بين أبي تمام والبحتري وشروط عمل اسم الفاعل.
في العمل أنا أرى إذا كان في الدنيا من يسمع رأيي أن نجعل مدة الدراسة الابتدائية والثانوية معًا سبع سنين على الأكثر، يتمكن فيها الطالب من العربية بالمران والتطبيق، وتنبيه السليقة، لا بحشو رأسه بالقواعد وقتل وقته وبمعرفة أوجه الأعراب حتى يقيم لسانه ويتنزه عن الخطأ الفاحش، ويبصر مرامي الكلام ودقائق معانيه، ويتعلم من دينه ما يمسك عليه إيمانه وخلقه، ويرغبه في الخير ويصرفه عن الشر، ويمنعه من الحرام، ويعرف من الرياضيات الشيء العملي الذي لا يستغنى عنه من غير اشتغال بالنظريات المجردة، وما لا بد منه من علوم الطبيعة وقوانينها الأساسية وأسرار المخترعات، وأن يدرس الصحة والجغرافيا والتاريخ العربي، وأن يعرف مبادئ لغة من اللغات الغربية، وأمثال ذلك، فما أردت الاستقصاء بل التمثيل.
فإذا تخرج الطالب منها عرضنا عليه فروع الجامعة، فإذا اختار فرعًا منها حضرناه له في سنتين أو ثلاث، علمناه فيه ما يتصل به، فيكون في كل كلية قسم تحضيري فيه من العلوم ما يحتاجه طالبها، فيتلقاها الطالب برغبة فيها وحب لها، لأنه هو الذي اختارها، ووافقت هواه، وظهر له النفع منها، وينجو بذلك من خلق شاعرًا من حفظ طلاسم الرياضيات، أو الرسوب فيها، والانقطاع عن المدرسة وحرمانه التحصيل من أجلها، وهو بعد لا يحتاج إليها أبدًا، ولا يتعلم كل طالب إلا ما يحتاج إليه مع اختصار مدة الدراسة، وتقوية الاختصاص، وكسب الوقت الذي يستطاع الاستفادة منه في تقوية الأجسام الرياضية، ومعرفة الوطن بالسياحات، والعناية بالتربية الخلقية والوطنية، ومن شاء بعد الاكتفاء بالدراسة الثانوية ودخول معركة الحياة لم نسلبه وقته، وسلحناه بثقافة عامة يعلو بها مستوى السوقة وأصحاب المهن، ومن أراد التخصص فتحنا له بابه، وعجلنا له دخوله وقويناه فيه، وهذا إيجاز للاقتراح والشرح حاضر إن شاء الله.
أما التعليم الديني فلنعد إلى مثل الطريقة الأزهرية الأولى مع إصلاح يسير فيها، فقد ثبت أنها أنفع وأجدى دنيا وآخرة، وأن تلك الثورة عليها حتى تم العدول عنها، والقضاء على الجامعة الأزهرية، كان فيها إغراق أدركناه الآن، وأنا أعرف الأزهر الجديد، وأعرف كليات ثلاثًا أنشئت على غراره في دمشق وبغداد وبيروت علمنا فيها كلها، وأشهد لله شهادة حق أن الأزهر القديم كان في الجملة خيرًا منها، إذ كان ... يطلبون العلم لله وللمعلم فصار أهله يطلبون العلم للشهادات والوظائف، فكانوا يصبرون على تلك الحواشي المطولات، وأن تكن عقيمة فصار هؤلاء لا يقرءون إلا خلاصات يجوزون بها الامتحانات، وكانوا علم... عاملين لدينهم، أهل تقى ... في سمتهم وسلوكهم وسرهم وعليهم، فصار بعض المدرسين وأكثر التلاميذ صار على حال من عرفها، فقد عرفها، ومن جهلها فلا ... عن الخبر.
وأنا لا أعمم ولا أطلب القول، وإنما أعني الكثرة.. أعرف، ولعل فيمن لم أتشرف بمعرفته خيرًا لم يصل إلـى علمه، ولا بلغني خبره... على أن تكون المدارس الدينية بمثابة مدارس الاختصاص لا يدخلها الطالب إلا بعد أن يدرس هذه الدراسة الثانوية، يفهم علومها، ويأخذ شهادتها؛ لأنها ثقافة عامة يحتاج إليها عالم الدين، وعالم الدنيا، والموظف، وصاحب العمل الحر. ولا بأس بعد بارتياد منارة العلم في غير بلادنا على.... يطلب فيها العلم المبني على المشاهدة، أما علوم ... وما أصوله عندنا، كعلم العربية فلا، وهذه الحماقة التي كان أتاها الفرنسيون إذ أرسلوا شبابنا يتعلمون العربية في باريس لا يجوز أن تعاد، وحسبنا أن صلينا نار وتجرعنا صابها، (ولا نزال نتجرعه) وأن أضحكنا الناس علينا، وزدنا طلابنا على ضعفهم في لغتنا ضعفًا، وعد أن نختار الطلاب الموفدين من ذوي الدين والخلق المشي، وأن نرسل معهم من الأساس الكهول المتزوجين، مراقبين ومرشدين. هذه كلمة صغيرة في موضع كبير أعرف أنها تثير مناقشة، وتحتمل جدالًا، وأنها لم تلم بأطراف الموضوع، ولم تستوعب البحث فيه، وإنما هي تنبيه إلى فساد، ودعوة إلى إصلاح [1]
[1] - منشور بالعدد: 145، بتاريخ: 8 ربيع الأول 1393هـ - 10إبريل 1973م.