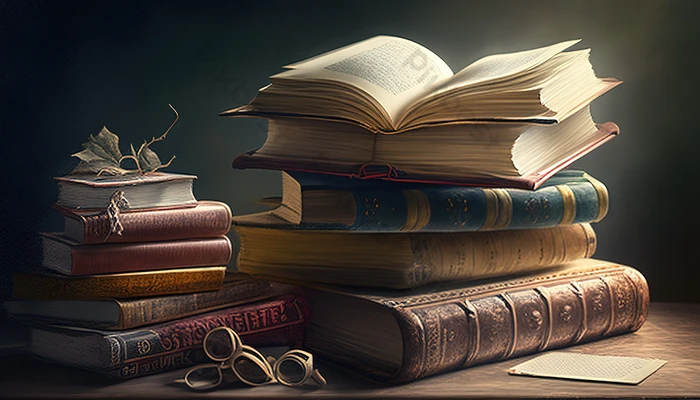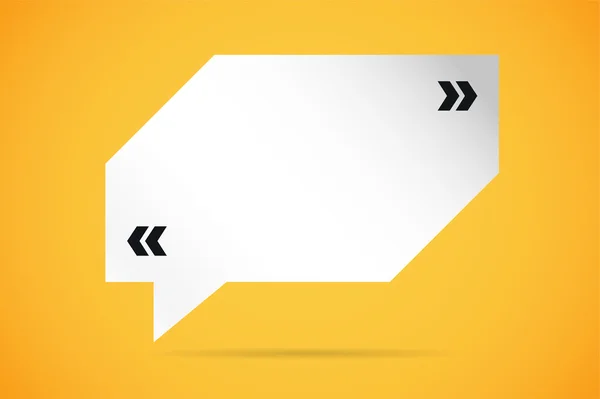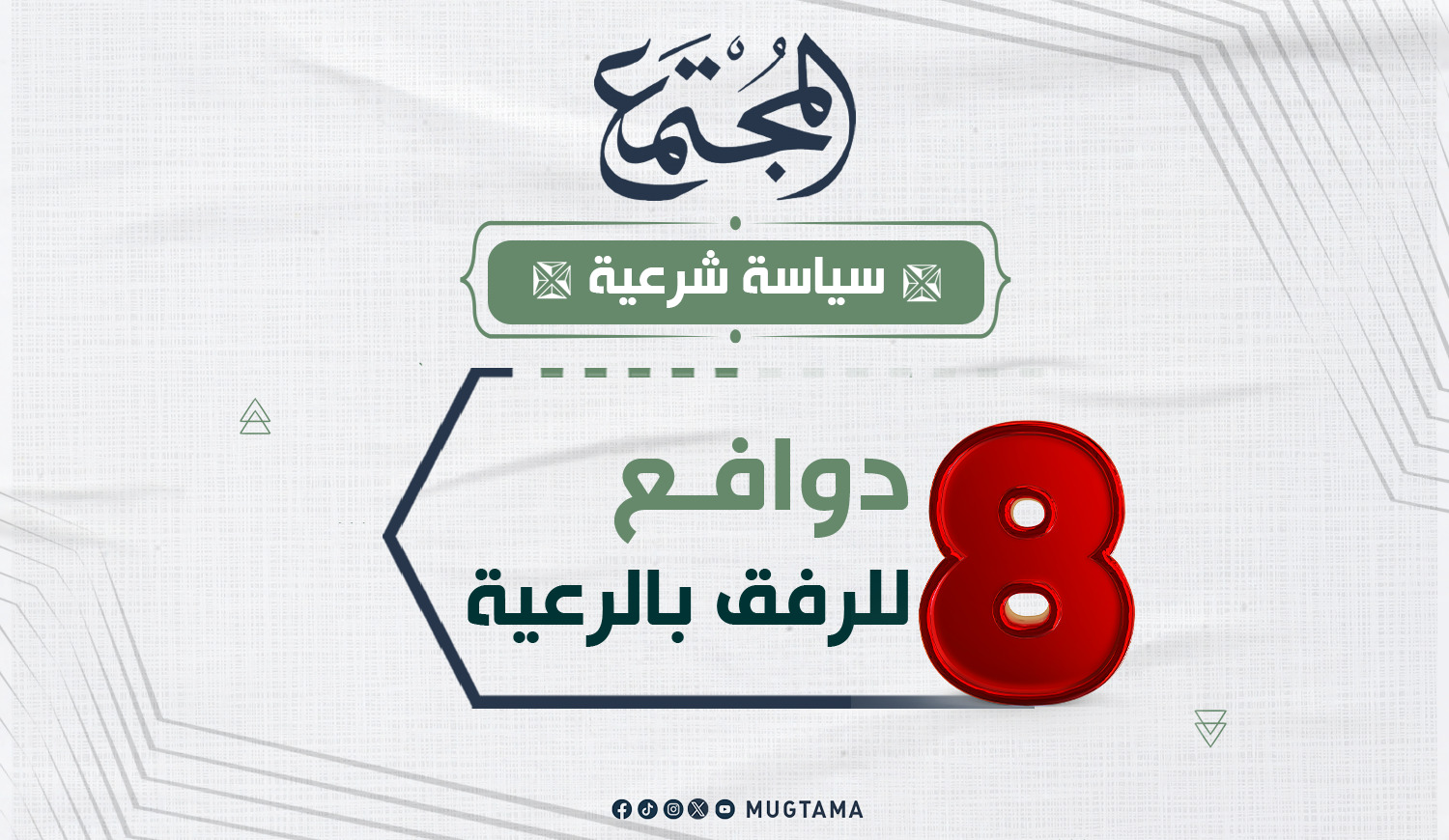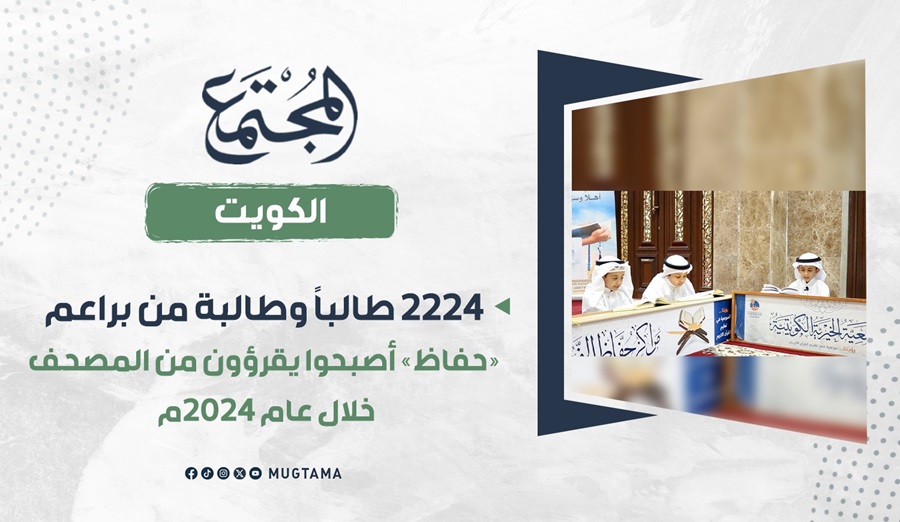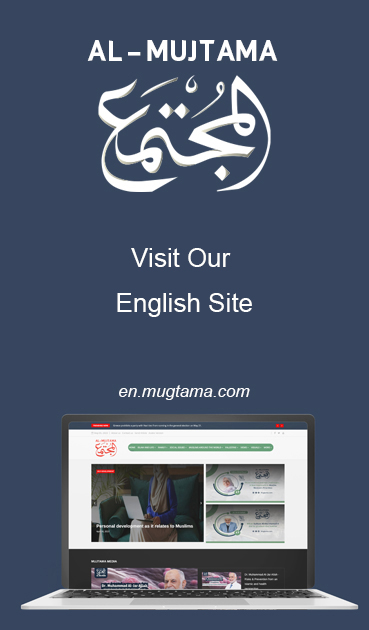حقوق المحكومين في التراث السياسي الإسلامي

حين صاغ منظرو السياسة الشرعية قواعد منظومة الحكم في الإسلام التي نظمت علاقة الحاكم بالمحكوم وحقوق كل منهما وواجباته انطلقوا في ذلك من قاعدتين:
الأولى: النصوص الشرعية التي تحدد حقوق الطرفين، وركزت على حقوق المحكومين وواجبات الحاكم الشرعي تجاههم.
والثانية: قاعدة أن كل حق يقابله واجب، فما هو حق للحاكم هو واجب على المحكوم، وكل واجب على الحاكم هو حق للمحكوم؛ وهو ما يعني أن الحقوق ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بأداء الواجبات.
وأما من جهة النصوص، ورد في الصحيحين: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»، وفي رواية لمسلم: «ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئاً ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»، وعن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة»، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الإمارة: «إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيهما».
وأما من جهة الحقوق التي فصل فيها الفقهاء وعلماء السياسة الشرعية، فهي أكثر من أن تحصى، فهي مبثوثة في كتب الفقه، وفي كتب السياسة الشرعية، وفي كتب الآداب السلطانية، ومن ذلك ما كتبه الجويني في «غياث الأمم في التياث الظلم»، وابن تيمية في «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، والماوردي في «الأحكام السلطانية»، وأبو بكر الخوارزمي في «مفيد العلوم ومبيد الهموم»، وأبو حامد المقدسي في «بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية»، والخيربيتي في «الدرة بيضاء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء».
وذكر هؤلاء المفكرون جملة حقوق واجبة للمحكومين، وما يلفت نظرنا فيها أمرين:
أولاً: تركيز الفقهاء (الجويني، وابن تيمية) على مسألة تطبيق القانون بالعدل على الرعية، وتوسعهم في مسألة اختيار الأكفأ لتولي المناصب وخاصة القضائية، ومراقبة الموظفين والعمال وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب.
ثانياً: تضمين الجوانب الأخلاقية والقيمية ضمن طائفة الحقوق، إذ ليست حقوق المحكومين حقوقاً مادية وحسب، وإنما هي أيضاً حقوق أدبية ومعنوية ينبغي مراعاتها.
وأما هذه الحقوق التي ذكرها هؤلاء فيمكن تلخيصها في الآتي:
- حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، وذلك بمنع البدع والفساد وإقامة الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من زلل، كما يقول الماوردي.
وحول هذا المعنى يذهب ابن خلدون إلى وجوب رجوع الحاكم إلى قوانين يخضع لها الكافة وهي قوانين يضعها العقلاء فتسمى سياسة وضعية، أو يفرضها الشارع وتسمى سياسة شرعية تنفع الناس في دنياهم ومعادهم؛ «ذلك أن الخلق (الرعية) ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها عبث وباطل، إذ غايتها الموت والفناء.. إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم.. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته على منهاج الدين ليكون محوطاً بنظر الشارع».
- فصل المنازعات القائمة وقطع المنازعات، بإقامة القضاة العدول وتطبيق القانون دون محاباة؛ «حتى تعم النصفة؛ فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم»، وإقامة العدل أصل استقرار الدولة، ولذلك يقول النويري: «ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف، فلا يقوم السلطان لأهل الكفر والإيمان إلا بهما، ولا يدور إلا عليهما».
- أن يأخذ على أيدي الظالمين، لا يظلم ولا يمكن أحداً من الظلم من عماله ونوابه ولا يرضى بظلمهم، فإنه مسؤول عن ظلمهم، وهم لا يسألون عن ظلمه.
- الاعتناء بحفظ الديار وحماية البلاد من اعتداء الأعداء، ولا يتحقق هذا إلا بجيش قوي مجهز بالعتاد والأسلحة، وهذا الجيش ينبغي ألا يزيد عدد أفراده على الحاجة فيجوعوا، ولا يقل فيضيعوا، كما يفترض إمام الحرمين.
- تولية المناصب أرباب الكفاءة والأمانة، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «ليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا»، وهذا التدقيق في اختيار أرباب المناصب لأجل أن «تكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة».
- أن يباشر بنفسه متابعة الأمور وتصفح الأحوال ومراقبة العمال، ولا يعول على التفويض، فقد يخون الأمين ويغش الناصح.
- بسط الأمن في ربوع البلاد ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال، فإذا اختل الأمن «لم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار، فإذا اضطربت الطرق، وانقطعت الرفاق، وانحصر الناس في البلاد، وظهرت دواعي الفساد، ترتب عليه غلاء الأسعار، وخراب الديار، وهواجس الخطوب الكبار، فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها، ولا يهنأ بشيء منها دونها»، كما يقول إمام الحرمين.
- أن ينتهج الرفق دون العنف في سياساته، فإن الإسلام بني على الرفق، والكفر بني على الخرق، «وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل الخرق في شيء إلا شانه».
- جباية الصدقات والزكوات والضرائب المستحقة على نحو ما أوجبه الشرع والمصلحة من غير عسف ولا محاباة، وصرفها في وجها الشرعي وفي تحقيق المصالح العامة.
- التصرف في الأموال العامة من غير إسراف أو تقتير.
- ألا يوصد بابه أمام أرباب الحاجات، بل عليه أن ينتظر مجيء أرباب الحاجات، ولا يستخف بهم، كما يذهب الخوارزمي.
وعلاوة على ذلك، فإن هنالك بعض الواجبات الأخلاقية التي يذكرها الخوارزمي في «مفيد العلوم» من قبيل ألا يعتاد الانهماك في الشهوات؛ لأن عاقبتها الندامة، وأن يقلع عن التكبر؛ لأنه أصل كل رذيلة، ولا يؤثر رضا مخلوق على خلاف الشرع.
وبالجملة، أفاض المنظرون الإسلاميون في الحديث عن حقوق المحكومين وعن واجبات الحاكم تجاههم، ومنها يفهم أن حقوق الحاكم لم تكن حقوقاً مطلقة، وإنما كانت مقيدة بإقامة أحكام الشرع وبسط العدل وأداء التزاماته تجاه المحكومين.