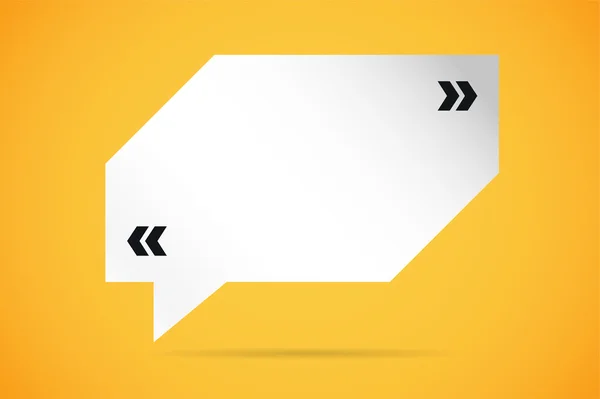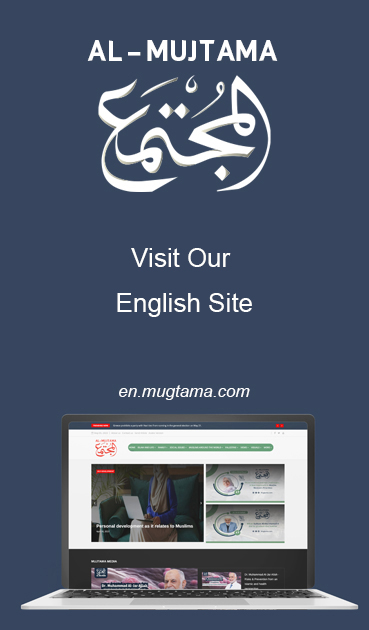عقيدة المسلم بين المواءمات السياسية والمعارك الميدانية

لا تختلف عقيدة المسلم ولا تضطرب، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، ولا يضطرها تَنَقُّلُ المسلمِ من حال إلى حال للتماهي مع الأحوال المتحولة، ولا يحملها تقلُّب الأوضاع على أن تتجشّم خطورة التردد بين المتناقضات، فخاصّيّتها الكبرى التي تميزها هي الثبات والرسوخ، وليس هذا جمودًا ولا تحجرًا؛ فإنّ المرونة والليونة لها موضعها، فلو شبهنا أمر الدين بالخيمة لكانت العقيدة عمودها الذي يتوسطها ويحملها ويثبتها حتى لا تقتلعها الرياح العاتية، وبديهيٌّ أن يستقلّ عمود الخيمة بوصف الثبات والرسوخ، وأن يضفي هذا الوصف على جملة الأوتاد الموزعة على أركانها، ويدع المرونة والليونة لحبالها التي يمكن أن تُشَدّ من جانب وتُرخَى من جانب آخر؛ لذلك جاءنا كتاب الله بآيات محكمات وأُخَرُ متشابهات، فالعقيدة وأصول الشرائع ومعاقد الأخلاق تسكن المحكمات، وما عداها يتردد بين المحكمات والمتشابهات.
المسلم بين الثوابت والمتغيرات
تتسع مساحة الثوابت في الإسلام لتشمل العقيدة ومواضع الإجماع ولا سيما المعلوم من الدين بالضرورة، ومعها الأحكام التي لا يسوغ فيها الخلاف، بينما تستقبل دائرة المتغيرات كل ما استنكفت طبيعته على البقاء ضمن الثوابت المحكمات، بدءًا من موارد الاجتهاد، وانتهاءً بمناطق من العفو التشريعيّ تُركت للتجربة الإنسانية وللعقل البشريّ لتبسط ظلالها على الأدوات والآليات والأمور الفنية والتقنية وما شابهها، وبين هذا وذاك من المتغيرات مساحةٌ لا بأس بها مما يشبه الغضاريف في الجسم الإنسانيّ، وهي مساحة الأحكام المنوطة بالعوائد وبالمصالح والمفاسد، مما يقال فيها: «لا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان».
والمسلم بين الثوابت والمتغيرات يسلك سبيلًا سهلًا ذلولًا لا اضطراب فيه ولا تعقيد، فأمّا الثوابت فهي على كل حال وفي أزمان أو مكان قائمة وصارمة، وبها تتحدد وتتضح وتبرز هوية المسلم، أيًّا كان وضعه الذي يعيشه أو واقعه الذي يحياه، هي مستمرة معه في العسر واليسر، في النشاط والكسل، في الإقدام والإحجام، في الحرب والسلم، وأمّا المتغيرات فهي أحكام وضعها الله للأحوال المختلفة، لكل حال ما يناسبه من الأحكام والتعاليم والتوجيهات والتصرفات، للحرب أحكامها وللسلم أحكامه، والمسلم يستدعي لكل حال ما يناسبه من الأحكام، بلا تداخل ولا تخليط، والثوابت حارسة على البوصلة.
الحديبية أنموذجًا
أرأيت كيف أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراع في الحديبية؟ تلك الغزوة التي التقت فيها القوة الخشنة مع القوة الناعمة، قوة التعبئة المعنوية للقتال (البيعة) مع قوة التفاوض السلميّ (الصلح)؛ ليصنعا معًا فتحًا مبينًا، وسواء كان عهد الحديبية هو الفتح أو كان هو الممهد للفتح فإنّ الله تعالى قد قرر في مطلع سورة الفتح أنّه فتح مبين، فهل رأيت تداخلًا في أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما كان من قبيل الثوابت المحكمات وما كان من قبيل المتغيرات وموارد الاجتهاد؟ فأمّا الثوابت فلا تفاوض فيها، بل من أجلها كانت البيعة تحت الشجرة، ولأجلها لم يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من ثوابت دينه طمعًا في مغنم قريب أو حتى رغبة في أن يبلغ الهدي محلّه، وأمّا المتغيرات ولاسيما ما كان منها منحازًا إلى الأمور الشكلية فكانت فيها المرونة التي بلغت حدًّا جعل الصحابة يوشكون على الدخول في حالة عصيان مدنيٍّ اعتراضًا على العقد، فما الذي يضرّ إذا اقتصرت الديباجة على البدء باسم الله فقط دون ذكر الرحمن، ما دامت لم تصرح بإنكار اسم الرحمن؛ إذْ السكوت عن حقّ لا يعني التصريح بخلافه، وما الضير في أن تنص الوثيقة على اسم رسول الله دون وصفه، طالما أنّ ذلك لا يتضمن التصريح بخلاف الوصف الرساليّ، وإذا كانت بعض البنود فيها مفسدة، فما الضير من تحمل هذه المفسدة في سبيل تحصيل مصلحة أعلى منها بكثير، وبهذا الفقه المتوازن جاءت الحديبية فتحًا سلميًّا مهد لفتح عسكريّ.
بين المواءمات والمصادمات
بين المواءمات السلمية والمصادمات العسكرية تذهب السياسة وتجيء، وفي أجوائهما تروح وتغدو، فالسياسة ليست محصورة في السلم، السياسة تدير السلم والحرب معًا وتدبر أمرهما جميعًا، فهي إمّا مواءمات سياسية وإمّا مصادمات عسكرية، والسياسة في اللغة والشرع معًا هي التصرفات التي تجعل الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وهذه التصرفات تتدرج من الليونة إلى الخشونة ومن المواءمات إلى المصادمات وتتنوع سلمًا وحربًا، كل ذلك بحسب المصلحة، وكل ذلك يقع في مساحة المتغيرات، ولا يؤثر في الثوابت المحكمات، فالمفاصلة مع العدو قائمة، والبراءة من الكفر والإجرام دائمة، والمواقف تجاه ما يخالف شريعة الله صارمة، فلا الهدنة - التي تقع فيها المتاركة من الجانبين - تجعل العدو صديقًا، أو المجرم الضالع في سفك الدماء بريئًا، ولا التحالف العسكريّ أو الاقتصاديّ يسوي بين الكافر إن كان متحالفًا والمسلم وإن كان متخالفًا، ولا الانفتاح على الكفار بيعًا وشراءً ومتاجرة ومشاركة واستثمارًا وتنمية وتبادلًا وتداولًا يضطرنا لاستباحة المعاملات المحرمة كالربا والغرر والاتجار في المحرم، وغير ذلك.
غير أنّ استقراء واقع العلاقات بين الأمم والدول والكيانات يؤكد أنّ نشاط الثوابت بما فيها الجمل العقدية يكون في الصدامات والمعارك أشدَّ، بينما في المواءمات السياسية يكون نشاط المتغيرات ولاسيما الجمل المرنة أشدّ، ومع ذلك فكلاهما موجود ويعمل في مساحته، لكنّ الذي يتغير هو الاستدعاء، فالصدام يستدعي الثوابت أكثر، والوئام يستدعي المتغيرات أكثر، فما أعظم شريعتنا! وما أروع التناغم والانسجام بين الثوابت والمتغيرات من الأحكام! وما أجدرنا أنْ نراعي هذه الخاصية ونعظم الاستفادة منها!
سورية الجديدة أنموذجًا
تقدّمَ الثوار من الشمال المحرر صوب المدن الشامية لتحريرها من قبضة الطغاة، فكانت العقيدة القتالية التي تستمدّ ماءها وغذاءها من ثوابت الدين هي الغالبة، فلا هوادة مع المجرمين، ولا إصغاء لإملاءات المرجفين، ولا تردد في إكمال المسار حتى الفتح المبين، والغاية والمقصد هو نصرة الحقّ وإعزاز الدين، وإلى جانب ذلك وجدت المرونة والليونة التي تسمدّ ماءها وغذاءها من الأحكام الفقهية الاجتهادية ومساحة المتغيرات، فمن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن ترك الميدان فهو آمن، ويا مَنْ اخترتم الاستسلام على العناد والإباء «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، إنْ قلنا: إنّها إستراتيجية قتالية لتحييد الجنود والعساكر الذين تم اقتيادهم للمواجهات بلا رغبة منهم من أجل تسهيل المعركة وتقريب النصر؛ وجدنا لذلك في فقه الجهاد مساغًا ومسلكًا، وإن قلنا: بل هي إستراتيجية تهدئة وطمأنة لكفّ المتربصين شرقًا وغربًا عن التدخل؛ لم نعدم من قواعد السياسة الشرعية موافقة ومعانقة، وإن قلنا بضرورة البناء على أرض تُنبت العفو والصفح وسط عالم يموج بالهرج والإجرام؛ لم نُحْرَم من مباركة الإسلام في مقصده العام؛ إذْ هو الدين الذي يسع الخلْق ويتسع للأنام.
وبعد استقرار الفتح بقيت تحديات جسام وعقبات ضخام، كيف نواجهها؟ هنا تضيق مساحة الثوابت، فتقتصر على ضرورة القصاص العادل الناجز من أئمة الكفر ورؤوس الإجرام استثناء من العفو العام، وعلى التمسك بقيم العدل والحرية وحقوق الأنام، وعلى الإمساك بمفاصل القوة والتأثير في البلاد لمنع تسرب المفسدين إليها وسطو جيوب النظام الهالك عليها، أمّا مساحة المتغيرات فهي أوسع، وفي قلبها ينصب الميزان، ميزان المصالح والمفاسد، فهذا وقت التزاحم والتدافع؛ إذْ لا يسع الثوار أن يحققوا جميع المصالح المرجوة ولا أن يدفعوا جميع المفاسد المخوفة، فيجب أن يُعمِلوا هنا قواعد الموازنة، فيختاروا في كل أمر تزدحم فيه الأمور وتتلاطم أهونَ الشرين، ويرتكبوا فيه أخف الضررين، ويدفعوا أعظم المفسدين باحتمال أدناهما، ويحصلوا أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، ويُفَعِّلوا قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.