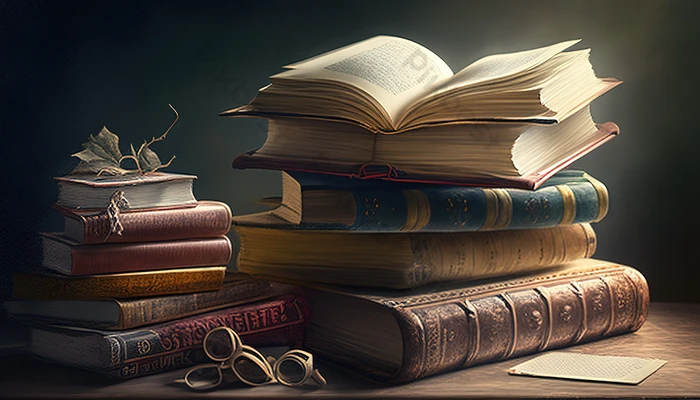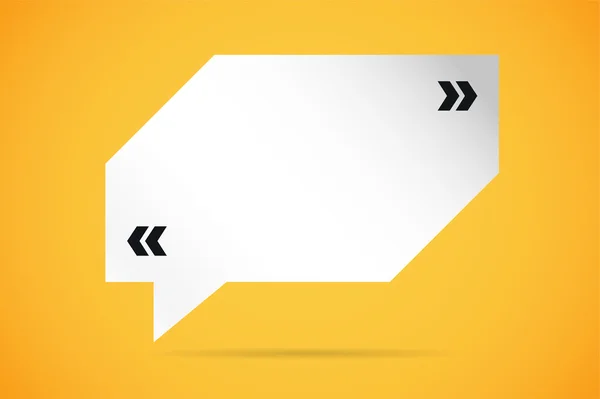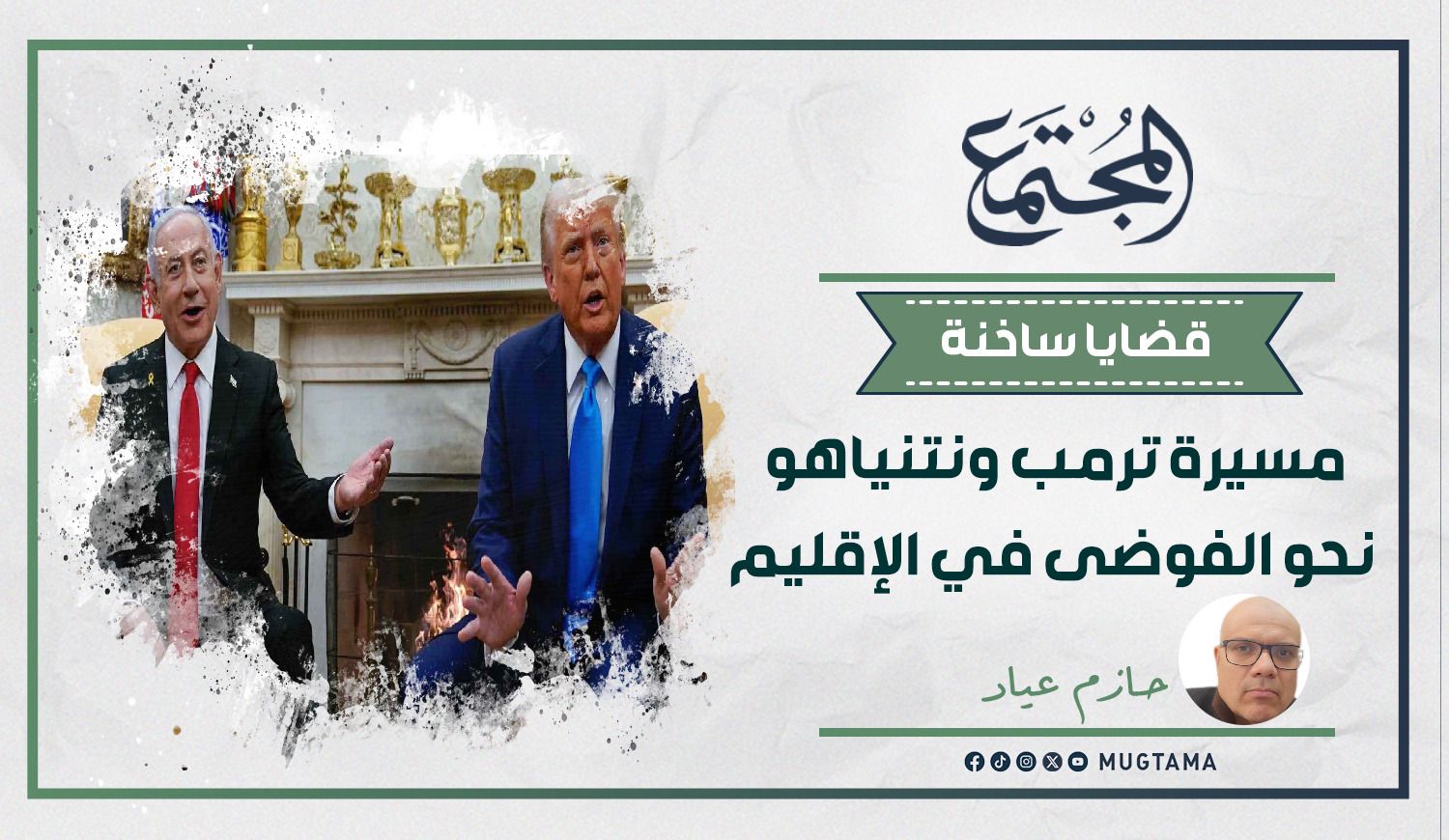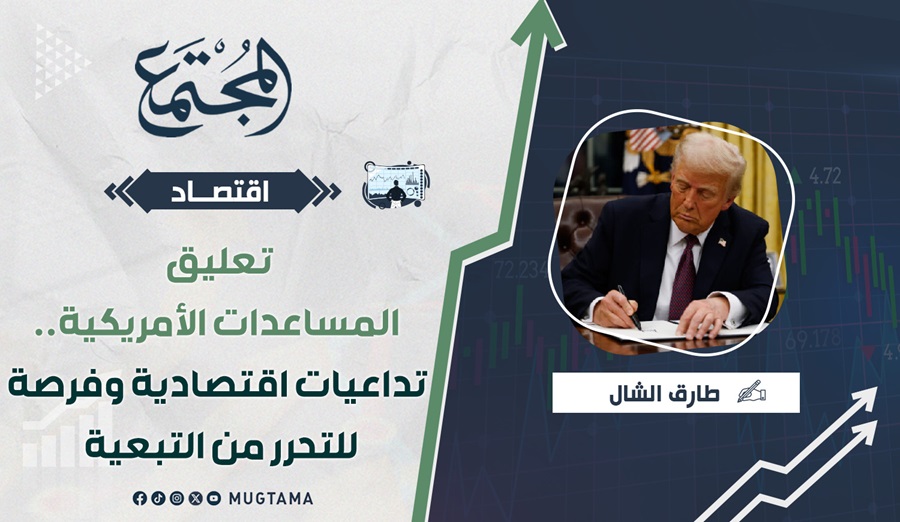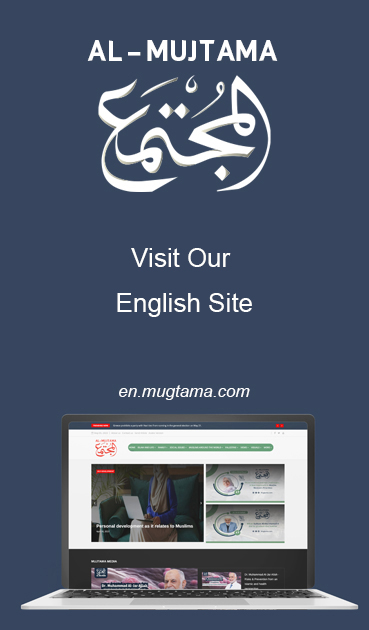قراءة في التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم..
هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟

منذ أن طرح فرانسيس فوكوياما، في مطلع تسعينيات القرن الماضي، رؤيته لـ«نهاية التاريخ» وهيمنة القيم الليبرالية مع سقوط آخر معاقل الشيوعية (الاتحاد السوفييتي)، ساد اعتقاد واسع بأنّ العالم قد بلغ عهداً من التعاون الدولي والإصلاحات الديمقراطية، وأنّ الولايات المتحدة ستتولّى دور الضامن لأمن عالمي مستقرّ.
لكن خلال العقود الثلاثة الأخيرة، انكشفت جوانب قصور منهجية في هذا التصوّر؛ فمن الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة، إلى الحرب على أفغانستان والعراق، وانتهاء بحرب الإبادة الجماعية في غزة، ومن العجز عن منع المجازر وحماية المدنيين إلى الإخفاق في بناء دول تحترم الحريات وحقوق الإنسان، تزعزعت الثقة في فعالية مؤسسات ما بعد الحرب الباردة كالأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
اليوم، في عام 2025م، ومع صعود أقصى اليمين المتطرف في أمريكا متمثّلاً بترمب وفريقه، تزداد التساؤلات عمّا إذا كان النظام العالمي في طريقه إلى التغيير، لا شكّ أنّ تراجع الولايات المتحدة نسبياً وصعود الصين السريع قد قوّضا النظام السابق القائم على الأحادية القطبية، وخلقا معطيات جديدة، لكنّ هذا التحوّل ليس مجرّد منافسة تقليدية بين دولتين عظميين، بل يواكبه إعادة توزيع شامل لأدوات القوة عالمياً.
تراجع الأحادية القطبية وصعود التعدّدية:
خلال حقبة الأحادية الأمريكية التي بدأت في أوائل التسعينيات، بدا أنّ قيم الديمقراطية وحرية السوق ستنتشر بلا حدود، مدعومة بفورة العولمة التكنولوجية والإعلامية، لكنّ الأحداث على مدار العقدين الأخيرين هدّمت هذه الأحلام؛ منها الحروب في الشرق الأوسط، مروراً بالأزمات المالية العالمية المتتالية وأزمات المناخ، وتنامي التوتّر التجاري والتقني بين واشنطن وبكين.
سؤال: هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ مرهون بقدرة الجميع على إدراك التهديدات الوجودية المشتركة
اليوم، أخذت دول كالصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا تبحث عن مسارات جديدة للتعاون الإقليمي، نرى في مجموعة «بريكس» ملامح تعاون مالي وتجاري موازٍ للمؤسسات التقليدية، وعلى الرغم من أنّ هذه التجمّعات لم تبلور بديلاً متكاملاً للنظام المالي القائم، فإنها باتت تعبّر عن إحباط الدول النامية من نموذج رأته غير عادل، خدم مصالح القوى الغنية وكبل اقتصادات البلدان الفقيرة بشروط قاسية للديون والإصلاحات.
الأزمات الاقتصادية وانهيار فرط العولمة:
شهدت العقود الأخيرة أزمات مالية متتالية، منها: الأزمة الآسيوية (1997م)، والأزمة العالمية (2008م)، وجائحة كورونا (2020م) وما تبعها من تذبذبات اقتصادية، هذه الأزمات دفعت عدداً متزايداً من الدول إلى إعادة التفكير في مدى تحرير أسواقها المالية والتجارية وفي جدوى اعتمادها المبالغ فيه على سلاسل التوريد المعولمة.
وفي الوقت ذاته، أدّت التوترات التجارية مع الصين إلى تعزيز النزعات الحمائية داخل الولايات المتحدة وأوروبا؛ فارتفعت الرسوم الجمركية، وتعالت الدعوات لإعادة التصنيع في الداخل، ومع أنّ هذا التوجّه لا يمحو العولمة كلياً، فقد يقود نحو تشكّل مجموعات إقليمية اقتصادية أكثر تجانساً.
التكنولوجيا.. فرص هائلة وأخطار تشريعية:
التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمية تعِد بإحداث طفرة في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة وغيرها، لكنها في الوقت ذاته تثير قلقاً هائلاً بشأن الخصوصية والأمن السيبراني، وتزايد الهوّة الرقمية بين الدول والمجتمعات، فالتدخلات الرقمية العابرة للحدود قد تهدد البنى التحتية للدول، وتزعزع الاستقرار الدولي.
تغيّر المناخ.. والاختبار القاسي للحوكمة العالمية:
لا شكّ أنّ أكبر اختبار يواجه النظام الدولي اليوم هو قدرة الحكومات والمؤسسات على احتواء التهديدات الوجودية الناجمة عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الحادة، فحتى بعد الاتفاقيات المناخية (اتفاق باريس)، فإنّ الإجراءات الحكومية ما زالت دون مستوى الطموح، والأحداث المناخية المتطرّفة تكشف هشاشة البنى التحتية في دول عديدة، وتُبرز عجز التمويل المتاح عن مواكبة احتياجات الدول الفقيرة أو الجزر المهددة بالزوال.
البديل سيتحدد وفق ما تختاره البشرية اليوم من سياسات وقرارات في الاقتصاد والتقنية والمناخ والسلام
إنّ تعطّل سلاسل التوريد الزراعية وانهيارات المحاصيل في بعض مناطق أفريقيا وجنوب آسيا يفاقمان من أزمة الهجرة والمجاعات، ويزيدان الضغط على الاقتصادات الأوروبية والأمريكية، هذه الأزمات تشير بوضوح إلى أنّ قواعد النظام الدولي الحالية ونمط العمل التطوّعي في ملفات المناخ قد لا يكفيان لتجنيب العالم أسوأ السيناريوهات.
حرب روسيا وأوكرانيا.. وإبادة جماعية في غزة:
كشفت الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب «الإسرائيلية» على غزة، عن الفجوة الكبيرة في تطبيق العدالة الدولية، وفشل مؤسسات الأمم المتحدة في منع الحروب، وعجزها الواضح عن ملاحقة مجرمي الحرب، وأكثر من ذلك، تحولت الأمم المتحدة إلى أداة لتمرير مثل هذه الجرائم عبر احتكار الدول الخمس الكبرى لحق النقض؛ ما رافقه طرح أسئلة معقدة حول قدرة هذه المنظمة العالمية على تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وقد شكلت مواقف الولايات المتحدة تحدياً غير مسبوق للإرادة الدولية، حيث تحوّل الموقف الأمريكي من مساند لأوكرانيا إلى ضاغط عليها مع وصول ترمب للحكم، كما أن دعوات الإدارة الأمريكية الجديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة وممارسة التطهير العرقي بحق شعبها مثلت واحدة من أخطر المحطات في عجز النظام الدولي بشكله الحالي عن مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية.
نحو أي مستقبل نسير؟
في ظل هذه التحديات المتعددة، يبدو العالم على مفترق طرقٍ قد يفضي إلى نظام عالمي أكثر تشظياً أو أكثر تعاوناً، من جهة، هناك مؤشرات على أنّ الدول الكبرى لن تختار المواجهة العسكرية المباشرة، بل قد تسلك مسار التنافس السلبي من خلال العقوبات الاقتصادية أو التحالفات الإقليمية والصفقات التجارية، ومن جهة أخرى، أدرك الجميع أنّ الأخطار العابرة للحدود لا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة.
لا تزال الأمم المتحدة، رغم ضعفها، قادرة على ممارسة دور المنسّق الدولي حينما تتوفر إرادة سياسية مشتركة، لكنّ هذا العالم بات اليوم أكبر من 5 دول؛ الأمر الذي يدعو لضرورة الإصلاح الشامل لهذه المنظمة، والإقرار بوجود قوى دولية وإقليمية فاعلة لا يمكن تجاهلها، كذلك قد نرى مبادرات جانبية بين كتلٍ إقليمية قادرة على بناء شبكات أمان اقتصادية أو سياسية عندما تفشل المنظومة العالمية في الاستجابة.
لكن السؤال المركزي اليوم هو: هل تتحول هذه المبادرات إلى بنى مؤسسية عالمية قوية تعيد صوغ مفهوم التعاون الدولي بما يتجاوز إرث القرن العشرين، أم يبقى النظام الدولي في حالة ترنّح بين محاور متنافرة لا تملك رؤية جامعة في الاقتصاد أو الأمن الجماعي أو المناخ؟
ما يجدر بنا إدراكه أنّ التحولات الحالية لا تشبه انهياراً شاملاً ولا ولادة نظام جديد دفعة واحدة، بل هي أشبه بحركة بطيئة لمراكز الثقل، أو كما وصفها البعض بـ«التغيير دون ثورة»، في ظل هذا المشهد، تبقى القوى الناشئة حريصة على التمسك بنسبية السيادة وعدم السماح بإخضاعها لمؤسسات دولية تقليدية، في حين تحاول الدول الغربية الحفاظ على ركائز النظام القديم مع إجراء تعديلات تحفظ لها نفوذها.
إن سؤال: هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ مرهون بقدرة الجميع على إدراك التهديدات الوجودية المشتركة، وبما إذا كانت القوى الكبرى ستختار الانخراط في هندسة نظام منفتح وشامل، أم أنها ستستمر في الانسياق خلف مصالحها الآنية الضيقة، ولئن فشلت الليبرالية المنتصرة في تحقيق وعودها السابقة، فإنّ البديل سيتحدد وفق ما تختاره البشرية اليوم من سياسات وقرارات في الاقتصاد والتقنية والمناخ والسلام.