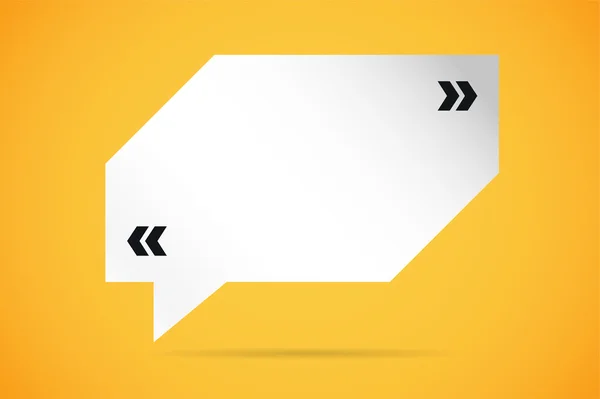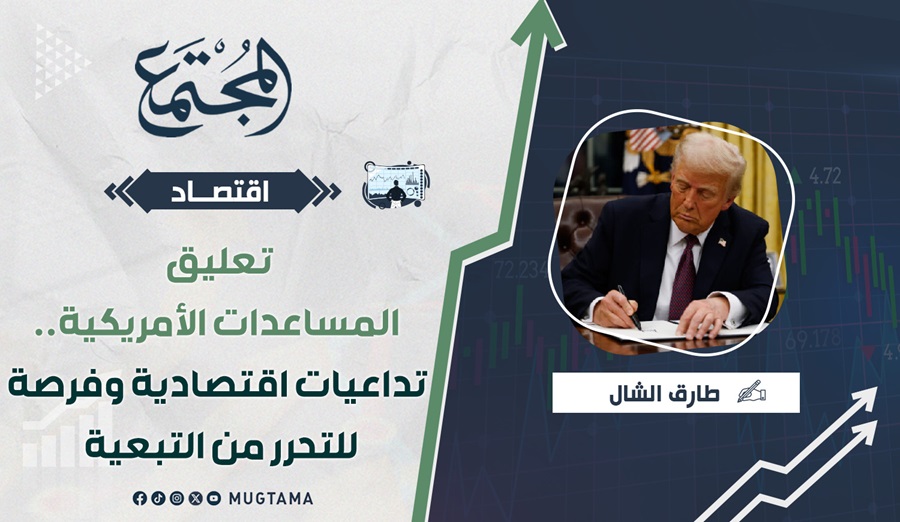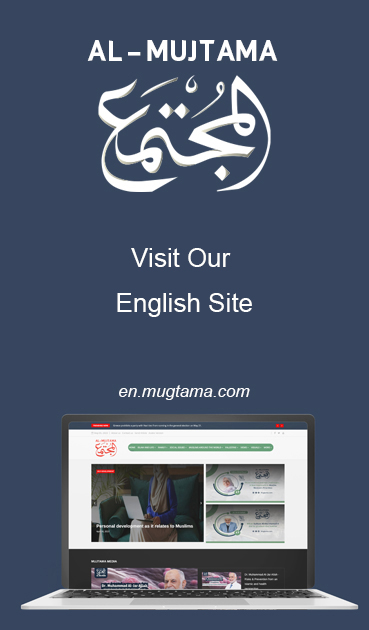معادلات غزة التي لم يستوعبها العالم!

مشهدان مترابطان تابعهما العالم في الإعلام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، كشفا عن حجم الجهل والتناقض في النظرة العالمية –والغربية منها بالذات– للشعب الفلسطيني، لا سيما شعبنا في قطاع غزة الذي خاض معركةً شرسة على مدى 470 يوماً كان عنوانُها «الإسرائيلي» باختصارٍ هو «الإبادة».
فالاحتلال جعل عنوان حربه في غزة التدمير لأجل التدمير، والقتل لأجل القتل؛ ولذلك لم يكن هناك بُد في النهاية من التوقف عن حربه العبثية بعد أن ثبت فشله في تحقيق ما أعلنه من أهدافٍ غير منطقية على مدى 15 شهراً.
المشهد الأول كان حين عرضت شبكة «الجزيرة» برنامجاً تحقيقياً بعنوان «ما خفي أعظم» للصحفي تامر المسحال حول عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023م، واستضاف المسحال فيه عدداً من المحللين والمتحدثين وبعضهم من الأكاديميين الغربيين الذين حاولوا تحليل أسباب ودوافع عملية «طوفان الأقصى»، وكان اللافت أن عنصراً واحداً غاب تماماً عن تحليلاتهم فيما يخص هذه الأسباب والمبررات.
فقد كان من الواضح أن المتحدثين الفلسطينيين في الوثائقي، الذين يمثلون المقاومة، ركزوا كثيراً خلال حديثهم في البرنامج على ما كان يجري في المسجد الأقصى المبارك قبيل عملية «طوفان الأقصى» باعتباره سبباً ودافعاً مباشراً للعملية، وأكد غيرُ واحدٍ منهم أن العملية جاءت في جزء كبير منها رداً على ما كان الاحتلال يقوم به في القدس وفي المسجد الأقصى من محاولاتٍ هدفت لتصفية قضيته تماماً والسيطرة على المسجد.
ولا ننسى هنا أن خطاب محمد الضيف، القائد العام لـ«كتائب القسام»، القائد الفعلي لعملية «طوفان الأقصى»، كان قد حدد في خطابه الأول، يوم 7 أكتوبر، 3 أهدافٍ لهذه العملية؛ أولها: كان وقف الاعتداءات «الإسرائيلية» على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وثانيها: كان تحرير الأسرى الفلسطينيين من معتقلات الاحتلال، وثالثها: كان رفع الحصار عن قطاع غزة.
فالمسجد الأقصى كان حاضراً بقوةٍ في أدبيات المقاومة الفلسطينية منذ بداية العملية وخلال الحرب، ولم يغب المسجد عن الأحداث يوماً، حتى في كثير من الفيديوهات التي كانت تنشر في وسائل الإعلام للشعب الفلسطيني في غزة خلال عمليات النزوح أو بكاء العائلات على شهدائها أو غير ذلك، حيث كانت القدس والمسجد الأقصى حاضرَين بقوةٍ في أدبيات الشعب الفلسطيني في غزة في عباراتٍ من قبيل «فدا القدس» و«فدا الأقصى» وغير ذلك.
والسؤال الذي كان يتبادر لذهني: لماذا لا يستوعب الغربيون مركزية المسجد الأقصى في هذه العملية؟
لدى مشاهدة الوثائقي كان واضحاً أن المحللين الغربيين استبعدوا تماماً أي علاقةٍ لما يجري في القدس والمسجد الأقصى بقرار المقاومة الفلسطينية القيام بعملية «طوفان الأقصى»، وجميعهم بلا استثناءٍ غضوا الطرف عن خطابات المقاومة حول هذا الموضوع، وكأنهم لا يرون في هذا الخطاب للمقاومة الفلسطينية أكثر من «استهلاكٍ إعلامي» أو مداعبةٍ للمشاعر الدينية لدى الجمهور العربي والمسلم، لا دافعاً حقيقياً لما يجري.
وهذا يدل على أن الدوائر الغربية لم تستوعب بعد درس معركة «سيف القدس» عام 2021م التي أطلقت فيها المقاومة الفلسطينية صواريخها على القدس في اليوم الأول رداً على ما كان اليمين «الإسرائيلي» المتطرف يفعله في ذلك اليوم في المسجد الأقصى المبارك وأمام باب العامود في القدس، والأمر نفسه ينطبق على «هبّة القدس» عام 2015م، وغيرِها من المواجهات، إذ لا يمكنك أن تستوعب عقلية مقاومة الشعب الفلسطيني دون هذا العامل الأساسي.
أما المشهد الثاني، فكان عودة مئات آلاف الغزيين المهجرين من جنوب قطاع غزة إلى شمالها بالرغم من علمهم المسبق أن الشمال مدمر بشكل شبه كامل، وهو ما حيّر عقول الإعلاميين في دولة الاحتلال وفي بعض الدوائر الإعلامية الغربية على حد سواء، حتى كانت العبارة الأكثر ترداداً في التعليق على هذا المشهد الأسطوري: «إلى ماذا يرجعون؟!».
ولعل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب كان الأكثر تعبيراً عن أسلوب تفكير هذه الدوائر الغربية حين اقترح «تحريك» سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر لأجل «تنظيف الأرض» في غزة، وهذا أغرب أسلوب للتعبير عن التطهير العرقي سمعته في حياتي!
«الإسرائيليون» والغربيون كما يبدو لا يفهمون معنى الأرض والارتباط بها بالنسبة للفلسطيني، ببساطة لأنهم –«الإسرائيليون» بالذات– ليسوا أصحاب الأرض، ولذلك نرى التناقض بين مشهدين؛ مستوطن «إسرائيليّ» يعلن بكل وضوحٍ رفضه العودة إلى مستوطنات غلاف غزة في الجنوب ومستوطنات الشمال المحاذية لجنوب لبنان، ما لم يتوفر له الأمن التام في هذه الأماكن من الدولة، علماً بأن الحكومة «الإسرائيلية» كانت إلى زمنٍ قريبٍ تستضيف مستوطني الشمال والجنوب في فنادق فاخرة قرب البحر الميت انتظاراً لهزيمة المقاومة الفلسطينية في غزة وهزيمة لبنان على الجبهة الشمالية.
هذا في مقابل مشهد الغزّيّ الذي يرجع رغم كل شيء حتى وإن كان إلى اللاشيء، فالمهجّرون الغزيون نزحوا عدة مراتٍ إلى الجنوب وحتى داخل جنوب غزة هرباً من قنابل الاحتلال التي كانت تلاحقهم في كل مكانٍ، بالرغم من تأكيدات الاحتلال أنها «مناطق آمنة».
وكان كثير من الغزيين لا يجد حتى خيمةً تؤويه هو وعائلته، دون أن ننسى المشاهد المفجعة لدخول الأمطار ومياه البحر إلى خيام النازحين جنوب القطاع.
ليأتي هذا المواطن الغزي العجيب ويفاجئ العالم بعودته مشياً على الأقدام إلى شمال غزة في مشهدٍ أذهل العالم! وقد شاهدنا على شاشات التلفزة عدداً من المقابلات مع هؤلاء العائدين وهم يؤكدون أنهم يعلمون أن بيوتهم مدمرة، وأنهم يرجعون إلى التراب، لكن في الوقت نفسه نرى كثيراً منهم يندم أصلاً على نزوحه، ويؤكد أنه لن يخرج من بيته مرةً أخرى مهما كانت النتائج.
هذان المشهدان اللذان حيّرا العالم الغربي –ودولة الاحتلال بالطبع بما أن أغلب سكانها غربيون أوروبيون أصلاً– لم يستوعب العالم الغربي أصولهما النفسية، إذ لم يتمكن من فهم طبيعة هذا الشعب وطبيعة هذه الأمة وارتباطها بالأرض كما ارتباطها بالمقدسات.
ولذلك، فليس من المستغرب أن يظن هؤلاء أن الشعب الفلسطيني ليس طبيعياً، وذلك لأن الطبيعي في نظر هؤلاء هو النظرة المادية التي اعتادتها الحضارة الغربية، فلا مكان لمفاهيم الوطن والأرض والمقدسات لدى كثير من هؤلاء للأسف، فكيف سيفهموننا؟
أذكر أني خلال دراستي في أوروبا، دخلتُ في نقاشٍ مع سيدةٍ أوروبية تحمل أفكاراً متعاطفةً إلى حد ما مع الاحتلال «الإسرائيلي» في فلسطين، وكان منبع نقاشها استغرابها من إصراري على استخدام كلمة «فلسطين» في النقاش، فقالت لي: لماذا تصر على أن تذكر تلك الأرض باسم «فلسطين» بينما هي الآن «إسرائيل»؟! لماذا لا تعترف بالأمر الواقع؟!
فقلت: لنفترض -يا سيدتي- أن محتلاً جاء إلى مدينتكِ هذه التي تنحدرين منها أنتِ وعائلتكِ منذ أقدم الأزمان، وأخذها منكِ بالقوة، ثم قرر في لحظةٍ واحدةٍ أن يغير اسمها ويسميها باسم «موز» أو «تفاح»، فهل تقبلين بذلك؟
فأدهشَتني بإجابتها: نعم، أقبلُ بالأمرِ الواقع ببساطة!
فلم أجد غير أن أعلق: يا سيدتي، إن كنتم أنتم شعباً ميتاً فنحن شعبٌ حيّ.
ولا أدري إلى اليوم ما إذا كانت قد فهمَت كلامي أم لا.