تعليق على ربانية التعليم (1 – 2)
المعايير النسبية لربانية التعليم
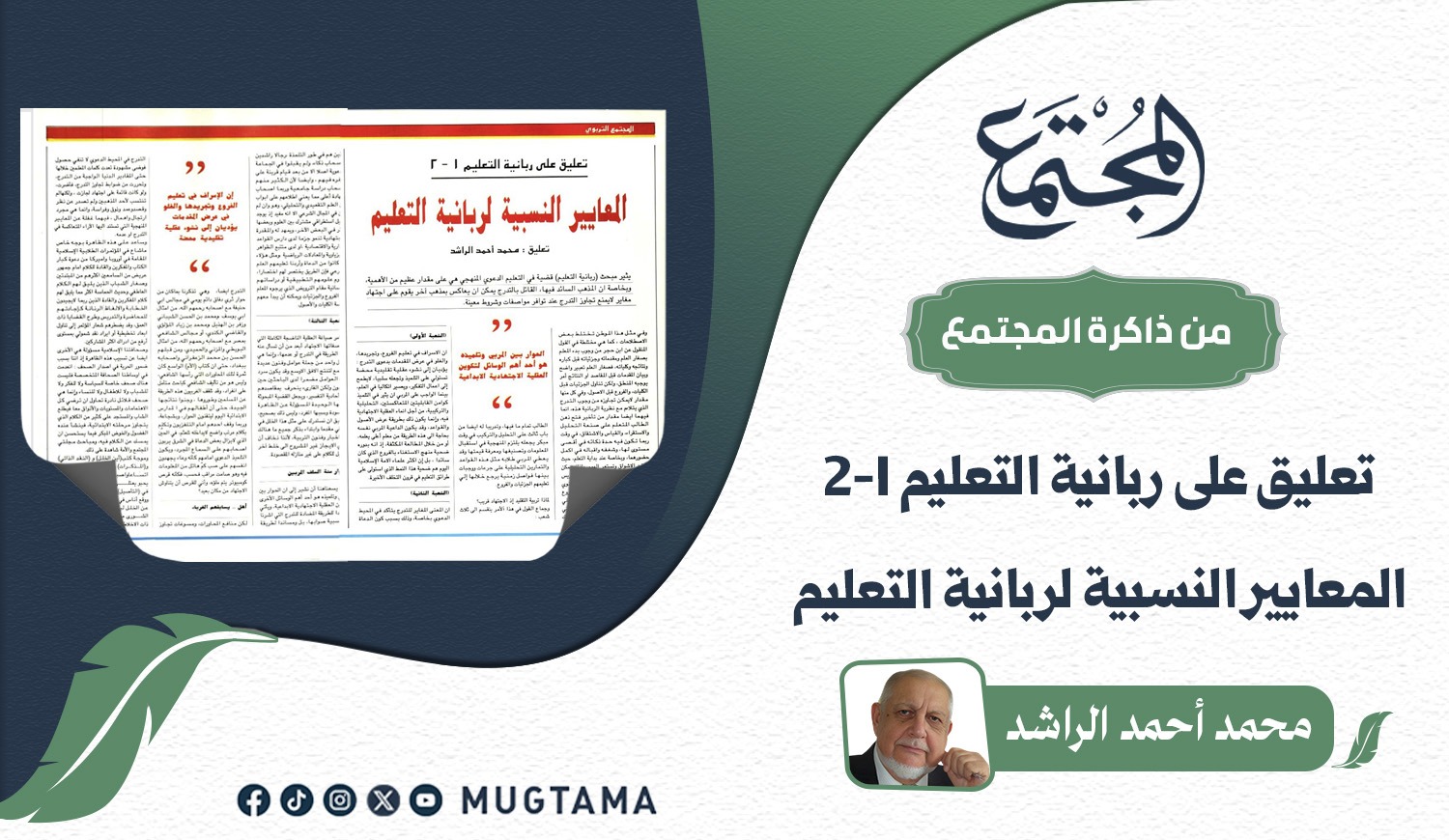
يثير مبحث «ربانية التعليم» قضية في
التعليم الدعوي المنهجي هي على مقدار عظيم من الأهمية، وبخاصة أن المذهب السائد
فيها القائل بالتدرج يمكن أن يعاكَس بمذهب آخر يقوم على اجتهاد مغاير لا يمنع
تجاوز التدرج عند توافر مواصفات وشروط معينة.
وفي مثل هذا الموطن تختلط بعض
الاصطلاحات، كما هي مختلطة في القول المنقول عن ابن حجر من وجوب بدء المعلم بصغار
العلم ومقدماته وجزئياته، قبل كباره ونتائجه وكلياته، فصغار العلم تعبير واضح،
وبيان المقدمات قبل المقاصد أو النتائج أمر يوجبه المنطق، ولكن تناول الجزئيات قبل الكليات، والفروع قبل الأصول، وفي كل منها مقدار لا يمكن تجاوزه من وجوب التدرج
الذي يتلاءم مع نظرية الربانية هذه، إنما فيهما أيضًا مقدار من تأخير فتح ذهن
الطالب المتعلم على صنعة التحليل والاستقراء، والقياس والاشتقاق، في وقت ربما تكون
فيه حدة ذكائه في أقصى مستوى لها، وشغفه وإقباله في أكمل حضورهما، وبخاصة عند
بداية التعلم؛ حيث تستبد الأشواق، وتستعر الهمم.
الإسراف في تعليم الفروع وتجريدها والغلو في عرض المقدمات يؤديان
إلى نشوء عقلية تقليدية محضة
ولذلك يمكن ويجوز لبعض المربين أن ينتهج
نهج تدريس العلوم من أعلاها، يذكر المهم قبل الثانوي، وذكر الكليات والقواعد
والموازين قبل الفروع والجزئيات والمقدمات استثمارًا لعاملي الذكاء والإقبال من
باب، وقذفًا لهذه المعاني في اللاشعور من باب آخر، وإن لم يدرك الطالب تمام ما
فيها، وتدريبًا له أيضًا من باب ثالث على التحليل والتركيب في وقت مبكر، يجعله
يلتزم المنهجية في استقبال المعلومات وتصنيفها ومعرفة قيمتها، وقد يعطي المربي
طلابه مثل هذه القواعد والتمارين التحليلية على جرعات ووجبات بينها فواصل زمنية،
يرجع خلالها إلى تعليمهم الجزئيات والفروع.
لماذا تربية التقليد إذ الاجتهاد قريب؟
وجماع القول في هذا الأمر ينقسم إلى ثلاث
شعب:
الشعبة الأولى:
إن الإسراف في تعليم الفروع وتجريدها،
والغلو في عرض المقدمات بدعوى التدرج، يؤديان إلى نشوء عقلية تقليدية محضة تستولي
على التلميذ وتجعله سلبيًا، لا يطمح إلى أعمال التفكير، ويصير اتكاليًّا في العلم،
بينما الواجب على المربي أن يثير في التلميذ كوامن القابليتين المتعاكستين-
التحليلية والتركيبية- من أجل إنماء العقلية الاجتهادية فيه، وإنما يكون ذلك
بطريقة عرض الأصول والقواعد، وقد يكون الداعية المربي نفسه بحاجة إلى هذه الطريقة
من معلم أعلى يعلمه، أو من خلال المطالعة المكثفة، إذ إنه بدوره ضحية منهج
الاستغناء بالفروع الذي كان سائدًا، بل إن أكثر علماء الأمة الإسلامية اليوم هم
ضحية هذا النمط الذي استولى على طرائق التعليم في قرون التخلف الأخيرة.
الشعبة الثانية:
إن المعنى المغاير للتدرج يتأكد في
المحيط الدعوي بخاصة، وذلك بسبب كون الدعاة الذين هم في طور التلمذة رجالًا راشدين
وأصحاب ذكاء، ولم يقبلوا في الجماعة الدعوية أصلًا إلا من بعد قيام قرينة على
توفره فيهم، وأيضًا لأن الكثير منهم أصحاب دراسة جامعية، وربما أصحاب شهادة أعلى،
مما يعني اطلاعهم على أبواب من العلم التقعيدي والتحليلي، وهو وإن لم يكن في
المجال الشرعي، إلا إنه مفيد إذ يوجد سبيل استطراقي مشترك بين العلوم، وبعضها يؤثر
في البعض الآخر، ويمهد له، والمقدرة الاجتهادية تنمو جزمًا لدى دارس القواعد
الإدارية والاقتصادية، أو لدى متتبع الظواهر الفيزياوية والمعادلات الرياضية، ومثل
هؤلاء إذا كانوا من الدعاة، وأردنا تعليمهم العلم الشرعي؛ فإن الطريق يختصر لهم
اختصارًا، وتقوم علومهم التطبيقية أو دراساتهم الإنسانية مقام الترويض الذي يرجوه
المعلم من الفروع والجزئيات، ويمكنه أن يبدأ معهم دراسة الكليات والأصول.
الشعبة الثالثة:
إن أمر صياغة العقلية الناضجة الكاملة
التي من صفاتها الاجتهاد أبعد من أن تسأل عنه هذه الطريقة في التدرج أو عدمها،
وإنما هي عامل واحد من جملة عوامل وفنون عديدة تجتمع لتنتج الأفق الأوسع، وقد يكون
سرد هذه العوامل مضمرًا لدى الباحثين حين يكتبون، ولكن القارئ ينحرف بمقاصدهم إلى
أحادية التفسير، ويجعل القضية المبحوثة كأنها الوحيدة المسؤولة عن الظاهرة
المرصودة وسببها المفرد، وليس ذلك بصحيح، ولا يليق أن نستدرك على مثل هذا الخلل في
التلقي مقدمًا وابتداءً بذكر جميع ما هنالك من أخبار وفنون التربية؛ لأننا نخاف أن
يؤدي الإيجاز غير المشروح إلى خلط آخر، وتنزيل للكلام على غير منازله المقصودة.
الحوار سُنَّة السلف المربين
وإنما يسعنا هنا أن نشير إلى أن الحوار
بين المربي وتلميذه إحدى أهم الوسائل الأخرى لتكوين العقلية الاجتهادية الإبداعية،
ويأتي مساندًا للطريقة المضادة للتدرج التي أشرنا إلى نسبية صوابها، بل ومساندًا
لطريقة التدرج أيضًا، وهي تذكرنا بما كان من حوار ثري دفاق دائم يومي في مجالس أبي
حنيفة مع أصحابه رحمهم الله من أمثال أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن
الهذيل، ومحمد بن زياد اللؤلؤي، والقاضي الكندي، أو مجالس الشافعي بمصر مع أصحابه رحمهم
الله من أمثال البويطي، والمزني، والحميدي، ومن قبلهم الحسن بن محمد الزعفراني
وأصحابه ببغداد، حتى إن كتاب «الأم» الواسع كان ثمرة لتلك المحاورات التي رأسها
الشافعي، وليس هو من تأليف الشافعي كباحث متأمل على انفراد.
الحوار بين المربي وتلميذه هو أحد أهم الوسائل لتكوين العقلية
الاجتهادية الإبداعية
وقد تلقف الغربيون هذه الطريقة عن
المسلمين وطوروها، وجنوا نتائجها الجيدة، حتى إن أطفالهم في المدارس الابتدائية
اليوم ليتقنون الحوار، وبشجاعة، وربما وقف أحدهم أمام التلفزيون وتكلم بكلام مرتب
واضح لا يداخله تلعثم، في الحين الذي لا يزال بعض الدعاة في الشرق يربون أصحابهم
على السماع المجرد، ويكون التلميذ الدعوي أمامهم كأنه وعاء يجهدون أنفسهم على صب
كم هائل من المعلومات فيه وهو صامت مراقب فحسب، فكأنه قرص كومبيوتر يتم ملؤه، وأنى
للقرص أن يتناوش الاجتهاد من مكان بعيد؟
أهل.. يسابقهم الغرباء
لكن منافع المحاورات ومسوغات تجاوز
التدرج في المحيط الدعوي لا تنفي حصول فوضى مشهودة تعدت كلمات المعلمين خلالها حتى
المقادير الدنيا الواجبة من التدرج، وتحررت من ضوابط تجاوز التدرج، فأضرت، ولو
كانت قائمة على اجتهاد لجازت، ولكنها لم تنتسب لأحد المذهبين، ولم تصدر عن نظر
وقصد وعمد وذوق وفراسة، وإنما هي مجرد ارتجال وإهمال، فيهما غفلة عن المعايير
المنهجية التي تستند إليها الآراء المتعاكسة في التدرج أو عدمه.
وساعد على هذه الظاهرة بوجه خاص ما شاع
في المؤتمرات الطلابية الإسلامية المقامة في أوروبا وأميركا من دعوة كبار الكتاب
والمفكرين والقادة للكلام أمام جمهور عريض من السامعين، أكثرهم من المبتدئين وصغار
الشباب، الذين يليق لهم الكلام العاطفي وحديث الحماسة أكثر مما يليق لهم كلام
المفكرين والقادة، الذين ربما لا يجيدون الخطابة والألفاظ الرنانة كإجادتهم
للمحاضرة والتدريس وطرح القضايا ذات العمق، وقد يضطرهم شعار المؤتمر إلى تناول
أبعاد تخطيطية، أو إيراد نقد شمولي بمستوى أرفع من إدراك أكثر المشاركين.
وصحافتنا الإسلامية مسؤولة هي الأخرى
أيضًا عن تسبيب هذه الظاهرة، إذ إننا -بسبب ضمور الحرية في إصدار الصحف- انعدمت في
أوساطنا الصحافة المتخصصة، فليست هناك صحف خاصة للسياسة، ولا للفكر، ولا للشباب،
ولا للأطفال، ولا للنساء، وإنما هي صحف قلائل نادرة، تحاول أن ترضي كل الاهتمامات
والمستويات والأذواق معًا، فيطلع الشاب والمستجد على كثير من الكلام الذي يتجاوز
مرحلته الابتدائية، فينشأ عنده الفضول والخوض المبكر فيما يستحسن أن يمسك عن
الكلام فيه، ومباحث مجلتي المجتمع والأمة شاهدة على ذلك.
وموجة كتب «أين الخلل؟» و«النقد الذاتي»
و«المذكرات» زادت رقعة الفضول اتساعًا، وأصبح ابن البارحة الذي يحبو يعتلي المنابر
ليعظ القادة، ويصول في «التأصيل»، ويجول في «الشورى»، ووقع أناس في الخلل إذ هم
يبحثون عن الخلل ليبرأوا منه، وأصبحت الشورى مشجبًا تعلق عليه تطلعات النفس ذات
الأخلاط(1).
للمزيد:
- الأسبوع الدراسي الأول.. والتحديات الجديدة
- رسالة وزير التربية إلى نظَّار المدارس في
الكويت
- لقاءات «المجتمع» مع الأستاذ خالد المذكور
المعيد بجامعة الكويت
- وزارة التربية تعلن مسؤولياتها في مطلع هذا
العام الجديد
- التنشئة العلمية للطفل المسلم ضرورة عصرية
- مناهج التربية الدينية.. بين الواقع
والمأمول
________________
(1) نُشر بالعدد (1008)، 20 المحرم
1413هـ/ 21 يوليو 1992م، ص48.

















