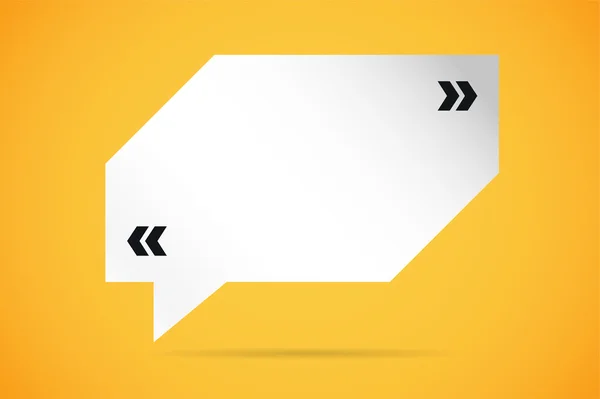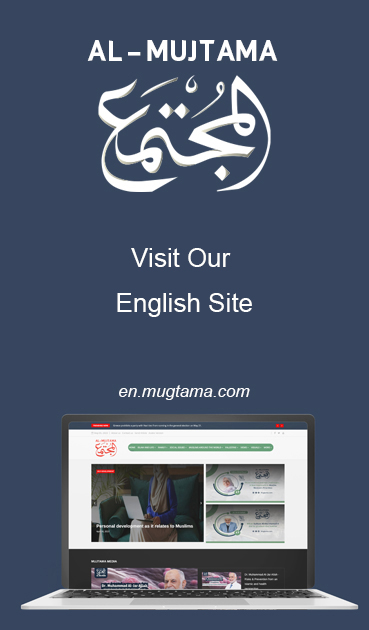قصة حقيقية على لسان شاب دمشقي (1)
أخي محمد!

في أغسطس 2024م، أقف لست ساعات متواصلة أحمل ملفاتٍ وأوراقاً بين يديّ.. أنتظر على باب المكتب حتى يأذن لي من يظن نفسه إلهاً أن أدخل لكي يطبع لي ختماً واحداً!
سعيد..
وأخيراً نادى باسمي.. وأخيراً.. الله أكبر (قلت في نفسي).
أخذ الوغد الأوراق من يدي، لم ينظر لأي كلمة فيها، نظر في وجهي وكشف عن أنيابه الملوثة بعروق الدخان، أرخى ظهره للخلف وقال: وكيف مات أخوك؟
- أخبرتك سيدي بأنه توفي بسبب الحمى.
ضحك، اهتزت أكتافه وأرسلت حنجرته الصدئة صوتاً يشبه صوت الصهاريج المتعطلة، أحسستُ بأن رائحة الصرف الصحي ستفوح إذا استمر ضحكه لثانية أخرى، فأسرعت بتغيير الموضوع وقلت: أنا وحيد أمي، وأصغر أفراد العائلة، وأمي تجاوزت الستين من العمر، كل الشروط متوفرة سيدي، وهذه كل الأوراق التي طلبتها الأسبوع الماضي..
قهقه الوغد، وهذه المرة شعرت بأن الصرف الصحي قد فار وصار فيضاناً في فضاء الغرفة، وقال: تقصد الشهر الماضي.. أو.. ألستَ تراجعنا منذ أغسطس الذي مضى؟ لقد راجعتنا لاثني عشر شهراً.. يا لك من فتى! كيف لم تيأس أيها الـ..
شتمني.. أخفضتُ رأسي، شعرتُ بأن النار تشتعل في عروق يدي، ولكني لا أجرؤ حتى على تكوير قبضتي فضلاً عن أن ألكم رأس الصهريج هذا.. تذكرتُ ذراع شقيقي محمد النحيلة، تذكرته كيف كان يحمل الرشاش وكأن الملائكة تحمل معه، فليس من المنطقي أن تتمكن هذه اليد النحيلة من حمل رشاش بهذا الوزن.. كان يلوّح بالرشاش ويصرخ بالرجال ويقول: والله لو لم نحمِ أرضنا فسوف يتلعّب صبيانهم بأعناقنا خمسين عاماً أخرى!
آه يا أخي لو أني أملك قوة إيمانك ويقينك.. آه كم يحترق فؤادي كلما ذكرتك يا أخي، وإني لا أنساك ولو للحظة!
تذكرتُ يده النحيلة وهي مصابة إصابة كانت كل أسباب الأرض تؤكد بأنها إصابة طفيفة.. كانت كل أسباب الأرض تقول بأنها لا تحتاج لأكثر من علاج في عيادة صغيرة.. كانت كل الاحتمالات تقول بأنه سيتعافى منها لو أن طبيباً وافق على علاجه.. ولكن لا أحد.. المستشفيات الرسمية بأيدي أتباع العصابة الطاغية، والعيادات الميدانية التي يفترض أنها لعلاج الذين يدافعون عن الأرض ضد العصابة الطاغية، تلك العيادات حين رأوا وجه أخي عرفوه لشهرته فهو قائد الكتائب التي تصدت لاقتحامات حزب الشيطان عشرات المرات ومنعتهم لحد الآن من دخول ريف دمشق، لقد عرفوا وجهه وعرفوا اسمه واسم أبيه وجده، وقالوا عنه: زنديق!
جدي كان شيخ الطريقة الصوفية، كان تلاميذه يقولون: من مثل شيخنا؟ يعلمنا القرآن والسنة النبوية والفقه واللغة والحساب والطب، وفوق ذلك كله يطعمنا ويحلينا!
كل دمشق تعرفه، وتعرف نبل أخلاقه وكرمه الفياض، والعلم في بلادنا حين يقترن بالكرم يصبح صاحبه سيداً لا يقارنه ملك ولا أمير..
ولكن حين غرست العصابة الطاغية خنجرها في عظام صدورنا، صارت حتى المذاهب تكفّر بعضها بعضاً.. فضلاً عن الطوائف التي عاشت ألفاً وأربع مئة عام مطمئنة إلى جوار بعضها، فجأة صارت مهددة بالإبادة من بعضها حين وصلت تلك العصابة المأفونة إلى الحكم.. عليهم من الله ما يستحقون.
أمُّ جدي كانت صيدلانية، والصيدلة في دمشق وريفها في أيام جدي وأمه لا تعني كما يظن أبناء اليوم بأنه شخص يقرأ خطوط الأطباء الغريبة ويقوم بإحضار علبة الدواء من الرف ويسلمها للمشتري، بعد أن يدفع الحساب.. كانت الصيدلة زكاة علم، وصناعة للدواء للمريض بذاته، لحالته لوزنه لطوله لطبيعة معيشته ولون بشرته وجفونه وعيونه!
وليس قالباً واحداً يسير عليه الجميع حتى لو ظهرت في بعضهم آثار جانبية!
يخبرني أبي بأن جدته الصيدلانية لم يكن عملها في الصيدلة مصدر دخل، لقد كانت من الغنى بما يكفي لتتخذ علاج الناس زكاة لعلمها وبركة وطلباً للحسنات، لا للأموال!
تعالج كل من يطرق بابها، لا تسأله عن اسمه ولا دينه ولا نسبه ولا مذهبه ولا أي شيء.. لا تطلب منه أجراً ولا حتى شكراً، تنظر في مرضه فتصنع له عقاراً يناسبه هو بذاته، تخلط المواد تصنع الدواء تعطيه للمريض فيتعافى بيومه أو خلال يومين لا أكثر، ولا يحتاج المريض بعدها لأي تحاليل ولا أشعة.. إن كان المرض مرضاً يعالجه الصيدلي فما الحاجة لأشعة أو تحليل؟ ليس إصابة جسدية من كسر أو جرح.. إنه محض مرض يمكن لصيدلانية عليمة أن تدركه بمحض النظر في وجه المريض أو أظافره!
ما الذي أصاب مجتمعنا ليصبح الطب له مقابل مادي بحت، بل ويمتنع لأسباب ما أنزل الله بها من سلطان!
لقد مات أخي لأن الأطباء رفضوا علاجه، وهو الذي كان يدافع عن المدينة ويمنع أراذل جيوش الأرض من اقتحام المدينة وقتل كل العباد وكل المذاهب وكل الطوائف ما لم تسجد لطغيانهم!
أخي لم يمت.. أخي كان شهيداً..
صوت الختم..
رفعتُ رأسي.. أيعقل!
الله أكبر.. وأخيراً، ختم الوغد على ورقتي!
مددتُ يدي المتشنجة لأستلم منه الورقة فسحب يده وعاد للخلف قليلاً، نظرتُ في وجهه وقد صار في حلقي جمرة تشتعل، قال الوغد: هناك شخص آخر يجب أن يوقع عليها أيضاً.. ستبقى هذه الورقة عندنا، وتعال بعد أسبوع لاستلامها.
تذكر.. بعد أسبوع فقط.. إن لم تأتِ فربما سنأتي نحن إليك.
- حاضر سيدي.
خرجتُ وأنا أتخيل وجه أمي حين تعلم بأني قد أضطر للالتحاق بالجيش بعد أسبوع لرفضهم التوقيع على إعفائي من الخدمة، رغم أني في قانونهم مستحق للإعفاء بكوني أصغر إخوتي، ولكوني مستحق للإعفاء ثانياً لأني صرت وحيد أمي بعد مقتل أخي.. ولكنهم يعرفون أخي جيداً.. ويعرفون بأنه كان آخر المدافعين عن الأرض ضد الغزاة الذين جاؤوا نصرةً للطاغية الذي جمع كل كلاب الأرض لتنهش لحومنا وتكسر عظامنا.. وسوطه فوقنا دوماً: إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم. قلاه الله بما شاء وكيف شاء.
أسير في الطريق الجانبي وعوادم السيارات تزاحم ذرات الأكسجين، أين دمشق التي يتحدث أبي عنها دوماً؟ إنني أمشي ملاصقاً لأسوار الجامع الأموي في الحارات العتيقة، ولكني لا أرى دمشق.. أين الياسمين الذي يغني لأجله كل عاشق في هذا العالم!
كيف يمكن أن يعيش الإنسان داخل القيثارة ثم لا يصيبه من رنة العود سوى ضجيج الألم.. مصابون بالصرع نحن؟ أم أن هذه الأرض لم تعد أرض العباد الصالحين!
لقد نزل بنا غضب الله، لقد خذلنا نبيه وصحابته، لقد متنا.. متنا جميعاً، وعاش منا الذين استشهدوا.. أولئك فقط سيحظون بالياسمين، سيحظون بدمشق كما تخبر عنها الأساطير: جنة الأرض، وفردوس الدنيا!
دخلتُ بين الأزقة الضيقة فهي أقصر طريق لمنزل جدي الذي عدنا لنقيم فيه بعد أن تم قصف منزلنا، بل والحي بكامله منذ عدة أعوام، لا تصل السيارات لباب المنزل، فهو في دمشق العتيقة، حيث تتزاحم البيوت كأنها شامة على جبين الأرض، حتى ترميم جدران المنزل يحتاج لتصريح وموافقة خاصة لكونه ضمن التراث الحضاري، أين الحضارة؟!
لقد انغمست خلف طبقات من الغبار الأسود، لا تدري هل هو من عوادم السيارات أم هي أنفاس القهر تزفر في الأرض لتحيل الهواء أشباحاً غابرة.
وصلتُ أمام باب البيت، أردت طرق الباب، ثم تذكرت، قد يكون والداي نائمَيْن، قفل الباب لا جدوى منه، دفعة بسيطة تكفي لينفتح هذا الباب، وضعتُ يدي على الباب لأدفعه، لمحتُ خدشاً قديماً.. تذكرتُ صوتَ أخي: سعيد، اضرب الباب بالفأس، اكسر الباب.. افتحه بأي طريقة، ليس لدينا وقت لنذهب إلى بيتنا لنحضر المفتاح، هناك الكثير من النساء وقد يأتي الأوغاد بأي لحظة!
لم أعرف ماذا أفعل، لو كان باستطاعتي أن أتحول إلى درج لتصعد أمهاتنا فوقي وتدخل منزل جدي المهجور لفعلت، ليتني كنتُ أضخم جثة لأدفع الباب وأفتحه، رحتُ أضرب الباب بجسدي، بكامل جسدي، لم أشعر بأي ألم على كتفي وظهري لم أفكر أصلاً، ضربتُ الباب بكل قوتي، تكسرت بعض أجزائه، أخشابه مهترئة فعمرها يزيد على مائتي عام.. ولكن القفل صناعة عثمانية.. لا تصدأ ولا تهرم!
وصل أخي، ضرب الباب برشاشه، استمر يضربه، ضربة تلو ضربة، كان صوت الرعد في السماء كأنما يخبئنا عن أسماع الأوغاد، انكسر القفل، فتحنا الباب، ودخلت الأمهات، لا أعرفهن ولكنهن نساء دمشق، لقد حققنا نصراً، نحن الفتية الصغار الذين لا يملكون سوى أسلحة تحمل باليد الواحدة، نحن نحن، تراجعت أرتال الأوغاد لخطوة واحدة أمام دفاعنا المستميت عن أحيائنا، فانطلقنا نوسع نطاق الاشتباكات، استطعنا الوصول لأحد الأفرع الأمنية، بمجرد وصولنا لعتباتها فر منها الأوغاد كفئران السراديب!
يتبع..