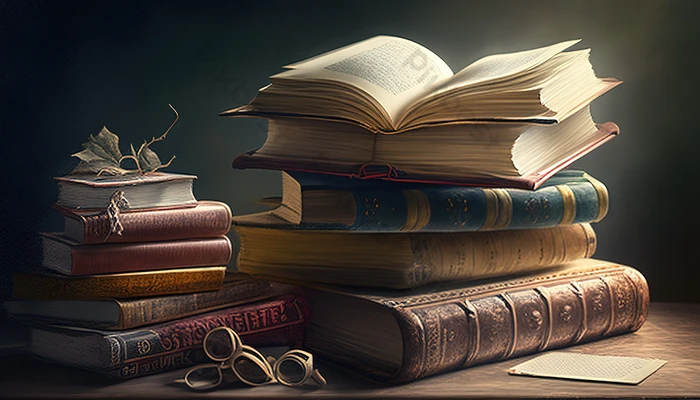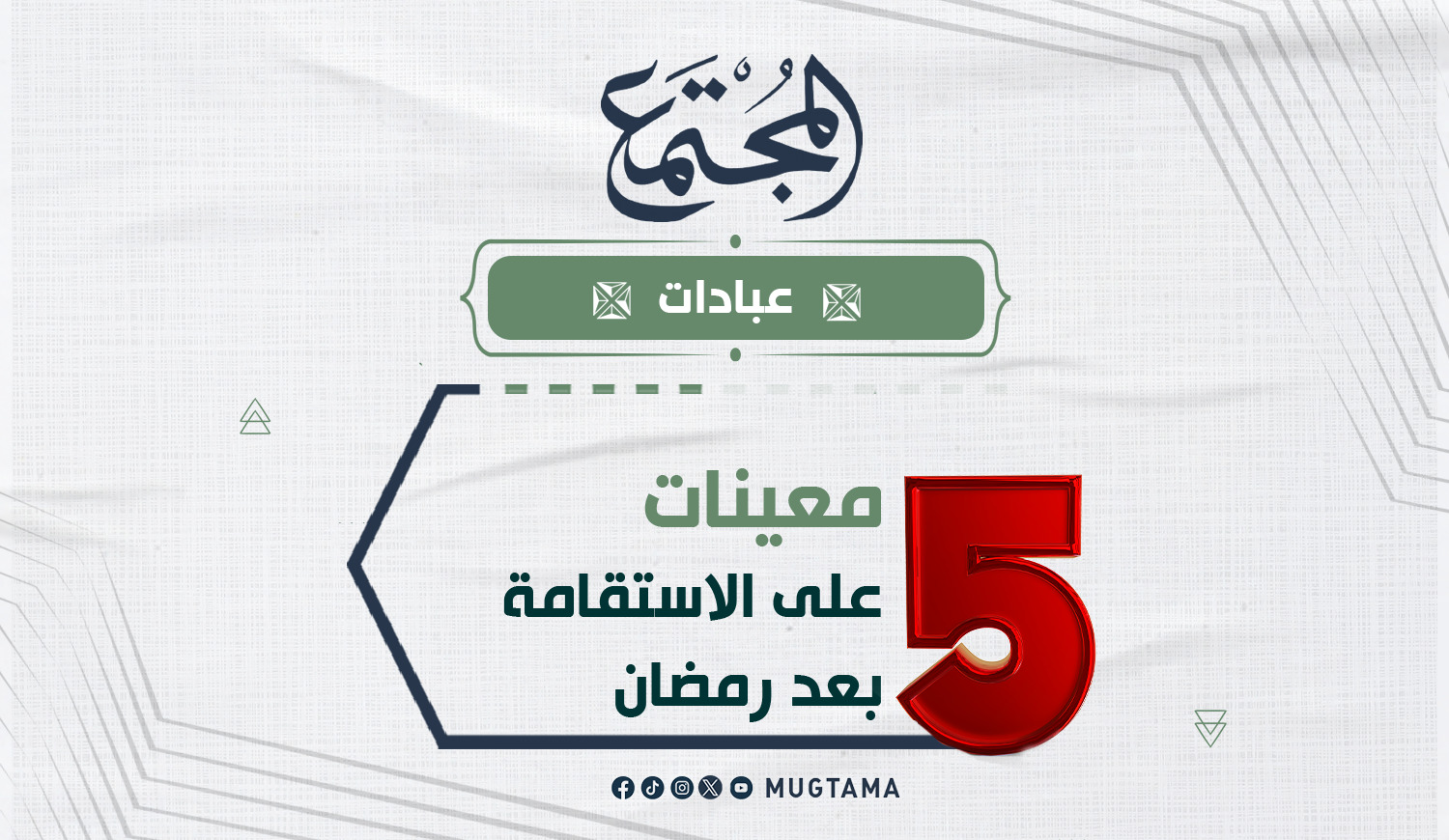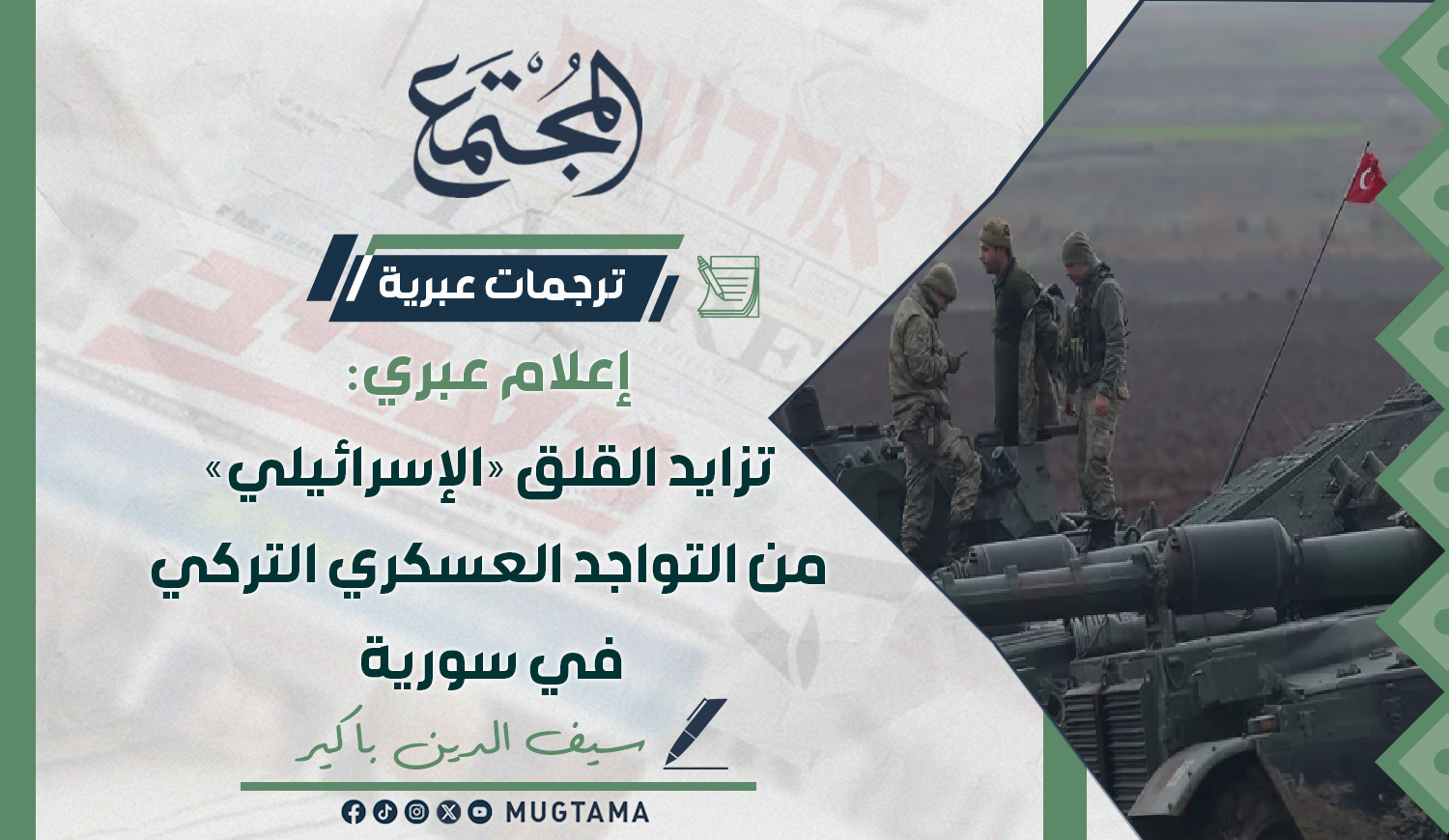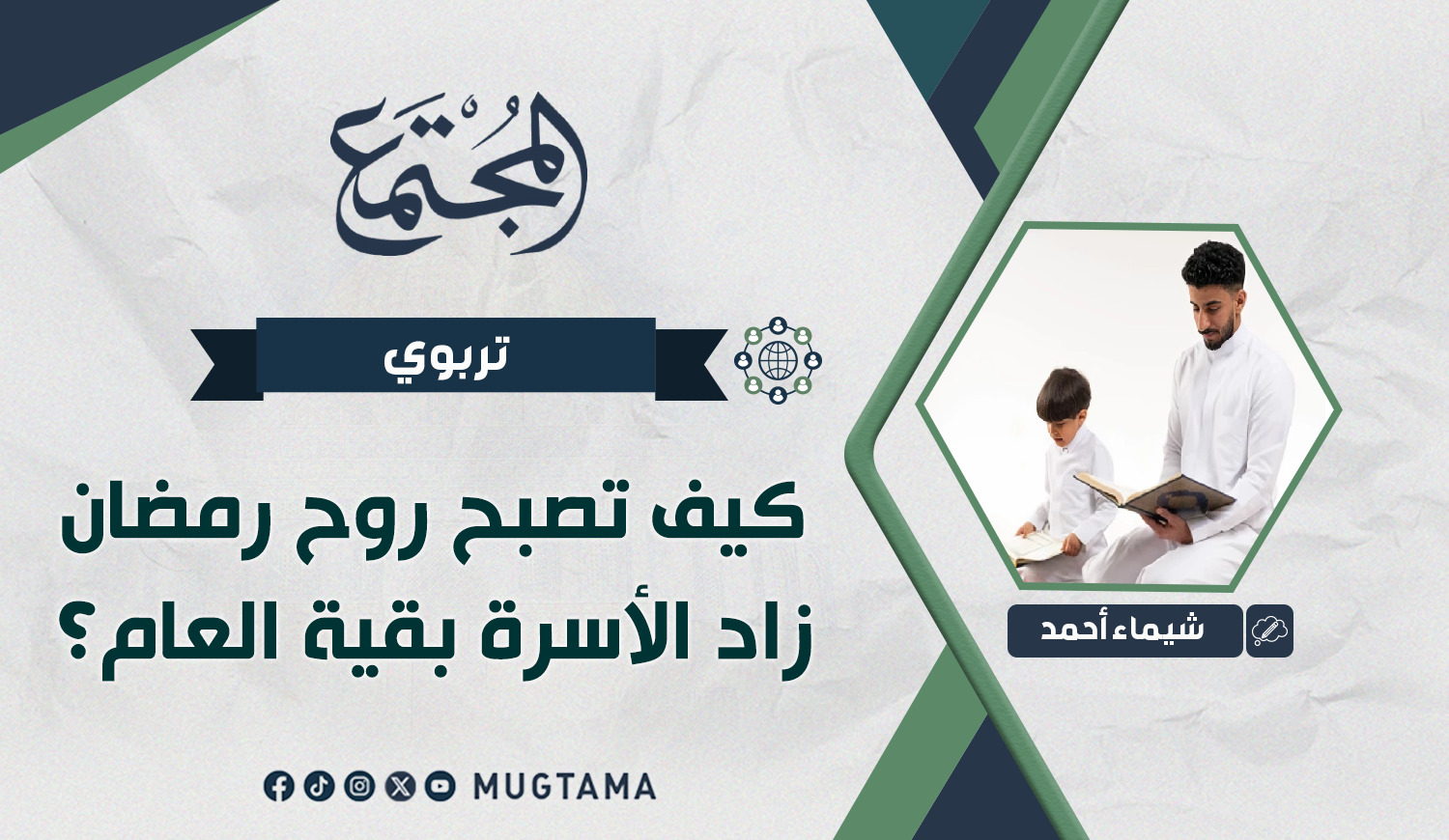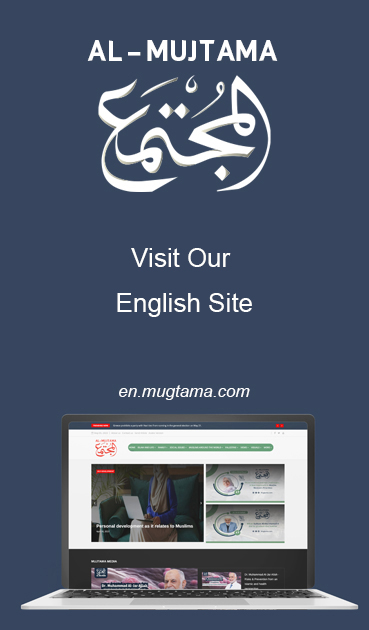عن التخفف من الملهيات وسدّ منافذ تفوير الشهوات

تَصُبّ مُدخلات
كافة منافذ الحواسّ مباشرة في القلب، وتبدأ عملها في قلب الكيان الداخلي للمرء، فهو
الميدان الذي يدور فيه الصراع بين النفس والشيطان، والمقتضيات والدواعي، بما
يُمْلَأ من الصور والمشاهد والمسموعات ومختلف اللذائذ المحسوسة بالحواس، لذلك
انتبه للمخزون الذي تعمر به قلبك، فإنّ منه قوتك وضعفك المَعنَويّيْن، وداءك
ودواءك معًا، وتأمل كيف أنّ الجَزَرة الواحدة إذا قسمتها قسمين، ووضعت نصفًا في
ماء مالح ونصفًا في ماء مُحلَّى، يكون نتاج الأولى مخلَّلًا والثانية مربّى، فمادة
التفاعل واحدة (الجزرة)، ومكمن اختلاف الناتج في اختلاف مُدخلات البيئة المحيطة.
ولأن سد منافذ
تفوير الشهوة أهون من تسكين الشهوة الفائرة، كانت قاعدة سد الذرائع مهمة في رحلة
تربية النفس وتزكيتها، ويتحقق سدّ الذرائع التربوي وضبط المُدخلات لمنافذ الشهوات،
بتطبيق 3 قواعد أساسية:
التخَفّف
من المُلهيات ومُهدِرات الطاقة
وهي عادات
وأعمال لا تَقصِدها عَمدًا، بل عَرَضًا وعَبثًا في الغالب، وتبدو عابرة هيّنة
وجيزة في حينها، لكنها بالتراكم والتكرار على المدى تشغلك، وتهدر من تركيزك وجودة
استثمارك لطاقاتك، كالتقليب العبثي في ألعاب الهاتف ووسائل التواصل في الأوقات
البينية، وكثرة اللف والدوران والتمطّع في الساعة التي تسبق النهوض للصلاة أو
الإخلاد للنوم، وما أشبه ذلك، وهدف التخفف من تلك المُلهيات ليس توفير الوقت
بالأساس، بل تربية النفس على عادة التركيز واليقظة في تخيّر الأعمال ومقاصدها،
والكفّ عن عادة التلهي وقتل الوقت وتشتيت الانتباه، ويمكن أن يتمّ التخفف بعمل
قائمة بتلك العادات والسلوكيات، وتصنيفها بحسب مدى أثرها، ثم النظر في جذورها
وأسبابها، ثم الاتفاق مع النفس على التوقف عنها أو استبدالها واحدة تلو الأخرى.
الكَفّ
عن الشرّ والحـذر من لملمة الآثـام
مما يغفل عنه
كثير من المسلمين أنّ ترك الشر وكَفَّ الأذى بحد ذاته خير يُحمَد عليه صاحبه، فعَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
صَدَقَةٌ»، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِد؟ قَالَ: «يَعْمَلُ
بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟
قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟
قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ
صَدَقَةٌ» (رواه البخاري).
وكما أنّ نفسك
هي أحقّ من كَفَفْتَ منه الشر، فهي كذلك أحقّ من كففت عنه الشر، وعلى رأسه شرور
مَحقّرات الذنوب وصغائرها، لأنها من هوانها عند صاحبها قد يعتادها ويألفها بسهولة
فلا تُومِض مؤشرات التنبيه عنده أثناءَها لرَدْعِه، ولا بعدها ليتوب منها، والطريف
أنّ غالب تلك الشرور الصغيرة تبدأ بالفضول في المباح: كمكالمة صاحب للاطمئنان على
حاله، وبالإطالة في الدردشة تتفرع المواضيع للخوض في أعراض الأصحاب الآخرين من باب
تناقل أخبارهم، ويُودِي ذلك الخوض لغيبة أو نميمة؛ وهكذا غالب مجالس السَّمَر
والدردشات المفتوحة!
فهذه اللملمة من
أكثر ما يأكل من أطراف الإيمان، ويجعل صاحبها عرضة للانزلاق فيما هو أكبر.
وتأمل في هذا
الأثر من كتاب «حِلْيَة الأولياء وطبقات الأصفياء»: مَرَّ إبراهيم بن أدهم برجل
يتحدث فيما لا يعنيه، فوقف عليه، وسأله: كلامك هذا ترجو به الثواب؟ قال: لا! فقال:
أفتأمن عليه العقاب؟ قال: لا! قال: فما تصنع بكلام لا ترجو عليه ثوابًا ولا تأمن
منه عقابًا؟!
ويلي
المُحقَّرات في الأذى، النقائص والمختلسات، وهي عادات صغيرة أو أفعال بسيطة، لكنها
مكروهة أو ذميمة، ينغّص عليك الوقوع فيها، وينتقص من تقديرك لنفسك وقدر إيمانك
تكرار ذلك الوقوع، ومع ذلك نتكاسل عن تتبعها، ونتجاهلها باعتبارها انقضت وانتهت، لكنها
تُظلِم علينا نفوسنا بتراكمها التدريجيّ وتسبب الاكتئاب والإحباط على المدى، مثال
ذلك: كثرة الصياح والعصبيّة، اعتياد ألفاظ بذيئة أو مقاطعة المتكلم، الفضولية وحبّ
التدخل في شؤون الغير، الثرثرة والقهقهة، دوام إساءة معاملة أو امتهان من هم دونك
أو أصغر منك.. إلخ.
وعلاجها يكون
بجلسة محاورة صادقة مع نفسك، تسائلها فيها عن كبرى الآفات والمعايب التي يسوؤك أن
تبدر منك، وعن الالتزامات التي تُحمّلها لنفسك وهي لا تستحق التحمّل أو لا تتطلّبه
على ذلك الوجه.. إلى آخر أنواع الأذى أو الضرر التي تشعرها في نفسك من نهج حياتك، ثم
تصنّفها حسب مدى تأثيرها، أو بحسب مجالها في علاقات البيت أو شؤون العمل، أو أي
معيار ترتيب يناسبك، ثم تضع مقترحًــــــا لتقويم كلٍّ على حدة، يشمل الرحلة
(الكيف) والمحطة (متى)، ولا يُشترط وضع المُقترح كاملًا لكلّ المآخذ، بل يكفي
الاشتغال بواحد أو اثنين بالتوازي (وربما أكثر بحسب ترتيباتك الشخصية)، ثم حين
ترتضي الناتج وتكتفي منهم، تنتقل لغيرهم، وهكذا.
الحضور
والاستحضار
التخفف من نهج
اتباع الهوى فيه صعوبة لا ريب، وتزداد الصعوبة حين يكون الكلام على هوى أدمنته
بحسب تمكّن لذة مادّة الإدمان في نفسك، من الأهمية بمكان التنبه لهذه الحقيقة في
مدافعة أي نوع إدمان، خاصة لو كان إدمان الفرجة والمرئيات؛ لأنّ قرب عهدك بلَذّة
المشاهدة ومتعة الاستلقاء والتلقي الخامل، يقوّي أَثَرها في شعورك، فتجد أنك فاتر
عن استبدالها بأمر آخر مُتعَته ليست حاضرة الأثر في نفسك بعد.
وهنا يأتي دور
الاستحضار، وإضافة الألف والسين والتاء تعني بذل الجهد وتكلّف الفعل حتى يتيسر لك،
فيصدُر عَفوًا ويَغدُوَ طَبْعًا، مثلًا، خذ دقيقة تفكّر تستحضر فيها أثر الفرجة
اللاحق عليك، وما تورثك إياه من تكدُّر وتحسُّر وهَدْر، أي تقارن اللذة العاجلة
بثمنها الآجل، فالنفس لَجوجة مُصرّة على حظوظها الحسيّة، ولا تتنازل عنها بسهولة، فعليك
أن تدافعها مرة بعد مرة، إما بإغرائها بالطمع في لذّة أشرف (كالثواب اللاحق، أو
كرامة ملك زمام النفس..)، أو بزجرها بالضرر المادّي الآجل (كالعقاب على الذنب
وشهادة الجوارح يوم الحساب، أو نكد الاتباع وتعاسة عبودية الهوى..)، فمما يعين
بإذن الله على مقاومة ميلك لمعاودة دوّامة الإغراق فيها وتجاوزها مرة بعد مرة
لنشاطات أخرى، تَكرار هذه الخواطر دوريًّا خاصة في غير أوقات الفرجة وقبل الإقبال
عليها بفترات لا قُبَيْلَها بسُوَيعات (لأنّ قُرب الفتيل من النار يزيد فرصة
الاشتعال).
وجدير بالتنويه
هنا أنّ التفكر والاستحضار النافعيْن لا بدّ أن يكونا جَادَّيْن، فالغالب أنّ
مُتَّبِع الهوى لا يتوقف ليتفكّر في عواقب استمراره على نهج الحياة الغافل اللاهي
وما سيؤول إليه عمره من هدر وحاله من همود؛ أو حين يتوقّف لا يتفكّر على الحقيقة،
بل بمجرّد أن يهتف به صوت العقل أو يخطُر على باله التفكير في العواقب يهرب إلى
لهوه سريعًا ليُسكِتَ ذلك الصوت ويَئِد ذلك الخاطر، فهذا ليس نوع ولا درجة التفكّر
التي تعين على تغيير نهج الحياة، وإنما هو أشبه بطنين مُزعج يورِثُ صاحبه الكَدَر
والنكد فيزيده تثبيطًا وركونًا!
بتطبيق هذه
القواعد المبدئية، تبدأ بتخليص نفسك من قبضة الاتباع الأعمى للهوى، والتملّص منها
شيئًا فشيئًا، والإفاقة من نشوة الغفلة وعَمى الانقياد، بتعويد نفسك طعم الرقابة
والمحاسبة والتفكّر في عاقبة حالك، ويتوازى مع ذلك إضعاف وطأة أثرها ومدافعة سَطوة
سلطانها على النفس، فتتسع المساحات المتكدسة بالملهيات سابقًا ليمكنك شغلها
بالمعمرات التي تعمر نفسك وحياتك في الدنيا والآخرة، بعون الله تعالى وتوفيقه.