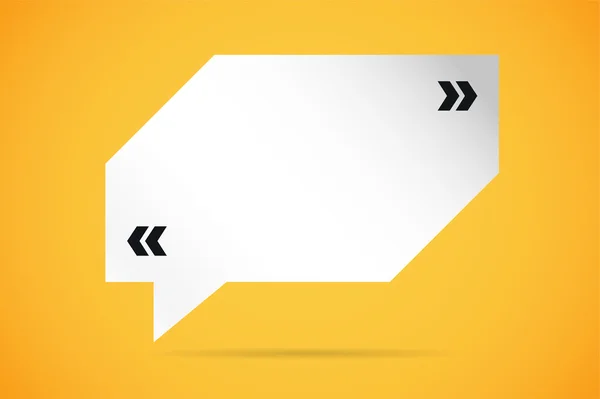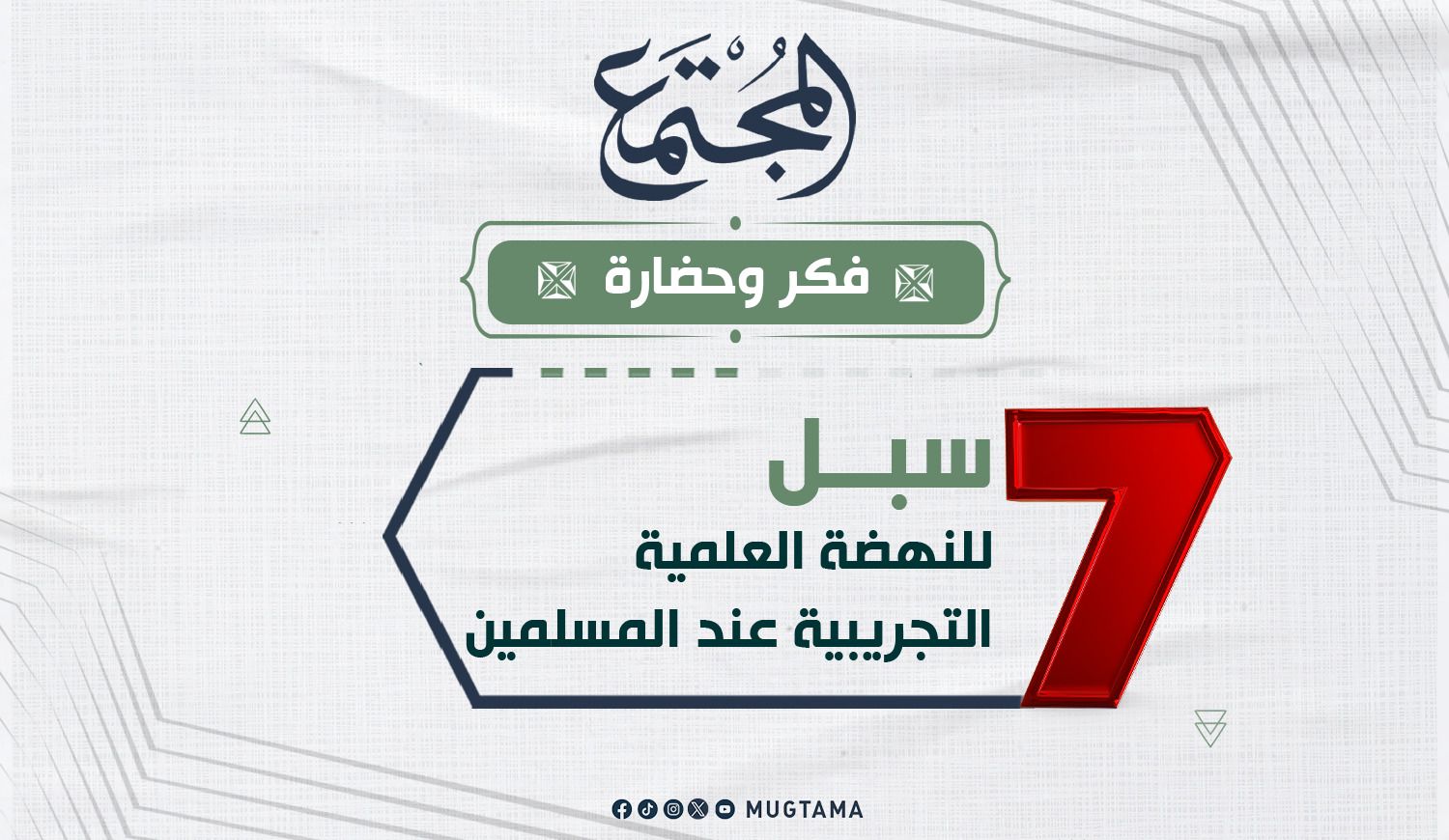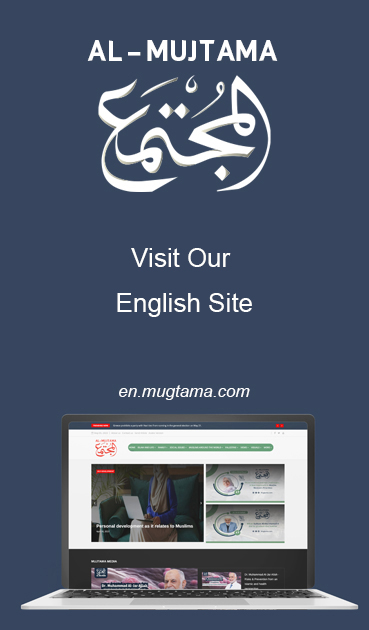كيف نتعامل مع الأزمات من حولنا؟

عبر مسار مفهوم الأزمة، نبدأ في عملية تحويل الأزمات إلى منتجات، فالأزمة نطاقها إما يكون ذاتياً أو مجتمعياً، ويتعدد نطاق الأزمات ليشمل: الحروب، قوانين تحد من الحركة، عوائق، كوارث بيئية، مظاهر التشريد والمخيمات، تكالب الأمم، جفافاً ولا مطر.. لذا، يبرز السؤال: كيف نتعامل مع الأزمات من حولنا؟
إن تمعنا النظر للأشياء المحيطة بنا مجدداً وفق منظور مختلف عما اعتدنا عليه، فإن تلك تعتبر أولى الخطوات التي تقربنا نحو التعامل مع الأزمات لنصل للإنجاز المبتكر، فمثلاً: ما عسى أن يكون الحذاء الذي نرتديه؟ وما عسى أن تكون وظيفته؟ لنقوم بعملية التحليل لنصل لما يلي:
أ- الحذاء: العناصر المكونة له: جلد، خيط، مقص، إبره، الوظيفة: حفظ القدم؛ وعليه، فإن أي مادة ستحفظ القدم سنعتمدها كمبتكر حتى وإن لم تكن من ذات المكونات.
ب- الكرسي: العناصر المكونة له: خشب بلاستيك مسامير قضيب معدني، الوظيفة: راحة للجسد؛ وعليه، فإن كل شيء يؤدي إلى راحة الجسد سنعتمده حتى وإن لم يكن من الخشب؛ هذا يعني أن تلك العناصر ليست ضرورية بقدر ما أننا نتطلع للوظيفة النهائية التي تؤديها.
إذاً، الخطوة الأولى في النظر إلى الأشياء من حولنا أن ننظر إلى العناصـر المكونة وما تؤديه من وظائف، والخطوة الثانية: لماذا هذه الوظيفة مهمة؟ وما درجة أهميتها لنا؟ وهل يمكن الاستغناء عنها؟ وما المفهوم الذي تحققه هذه الوظيفة؟
مثال: الكرسي، يعزز لمفهوم الاطمئنان والاسترخاء والابتعاد عن الضغوط أو القلق، فما وسائل تحقيق الاطمئنان في غير نموذج الكرسي؟ العطر، يعزز لمفهوم النظافة، والاسترخاء والاطمئنان، فهل هذا يعني أن العطر والحذاء جميعاً يعززان ذات الوظائف؟ بالطبع لا، ولكن حاجتنا لمفاهيم الاطمئنان والنظافة والسلامة والراحة أوجدت لنا نماذج العطر والحذاء والكرسي.
نكون بذلك قد توصلنا إلى حقيقة؛ وهي أن كل ما حولنا من منتجات إنما هو ترجمة لبنية تحتية من المفاهيم، وكل منها يقوم بوظيفة، وهذه الوظيفة معززة لمفهوم ما يحتاج إليه الإنسان في لحظة ما أو وفق نمط ما؛ إذاً، نحن محكومون ببنية تحتية من المفاهيم وليس ببنية تحتية من المنتجات، ذلك أن المنتجات كنماذج تتغير، ولكن المفاهيم تظل واحدة لا تتغير.
فحاول على الدوام أمام ما يصادفك من منتجات أن تتعرف على وظيفة المنتج، ومن ثم المفهوم الذي أدى لوجوده، ولكن حيال التعامل مع «الأزمات» كيف سيكون المسار؟ وما قواعده؟ فحيال الأزمات نحن هنا أمام مرحلتين:
1- أزمة مفاجئة، مثل: حرب، أو كارثة طبيعية.
2- أزمة تأقلم عليها الناس، مثل: جفاف لسنوات، مخيمات ما بعد انتهاء الحرب لسنوات كالمخيمات الفلسطينية، أو اضطهاد سياسي في بلد ما جعل الناس يتأقلمون مع حياة الفقر.
ومع هاتين المرحلتين ثمة ما يدعو للإنجاز، ولكن لكل ظرفه وميزاته، فلم يكن من السهل إرشاد غاندي لفكرة المقاومة للمستعمر البريطاني، من خارج الهند، عبر انتفاضة الملح، ولم يخطر ببال أحد أن يكون سلاح مقاومة الغزاويين لـ«القبة الحديدية» المدعومة بالتكنولوجيا الفضائية، عبر أنفاق من تحت الأرض أو بطائرات ورقية حارقة؛ وعليه، نلاحظ الدرس الذي تعلمه «الإسرائيليون» والأمريكيون معاً من نقاط ضعف سلاحهم هذا.
نحن بصدد منتجات ومشاريع يتم تفريخها وإنتاجها من الذين يعانون بأنفسهم، لا ممن هو في مختبره المزود بكامل التجهيزات والمدعوم بمبالغ استثمارية عظيمة، منتجات تحظى بمذاق تختلف فيه دوافع الإنتاج وما يحركها من مشاعر، ولك أن تقارن حيال عنصر المشاعر لفرق منتج كالمزهرية أنتجتها يد يتيم يعيش في مخيم للنازحين، مع مزهرية صنعت في الصين.
وعليه، وبناء على بعض جولاتنا الميدانية التي شملت العديد من الدول العربية والإسلامية التي مرت بظروف من الأزمات المماثلة، فنحن ندعو هنا لاستثمار تلك الظروف بما ينتج عنه مشاريع ومنتجات ترتقي أولاً بمن يعايش الأزمة فتنتشلهم مما هم فيه نحو أجواء منزوعة التوتر، وكذلك بما قد يتمخض عن تلك المشاريع والمنتجات ما يأخذ بأيدي البشر لأنماط حياتية إيجابية غير مسبوقة، ويكون لها عوائدها الاقتصادية والتنموية على أهل البلد.
سواء شملت تلك المشاريع مجالات: الصحة، والتعليم، والإغاثة، والصناعة، والإيواء.. بدلاً من انتظار انقشاع الأزمة، فها هي أزمة الفلسطينيين ما زالت مستمرة إذ تعيش اليوم عقدها السابع.
وثمة مؤشرات إيجابية بلا شك ناجمة عن أزمة فيروس «كورونا» التي اجتاحت العالم عام 2020م، منها على سبيل المثال: انخفاض معدلات التلوث الجوي؛ وهو ما سيكون له مردود إيجابي على طبقة «الأوزون» التي أصابها الخلل، واتساع فكرة التعليم عن بُعد واعتمادها كملاذ آمن في استكمال التعليم عوضاً عن التعليم النظامي المكلف في تشييد الأبنية وزحام الطرق وكلف التشغيل، وانحسار الاعتماد على السلع المستوردة لصالح المنتجات الوطنية، وهو ما سيكون له عائد على تشغيل الأيدي العاطلة، ويخفض من نسب البطالة في قطاع كانت نسبته ضئيلة.