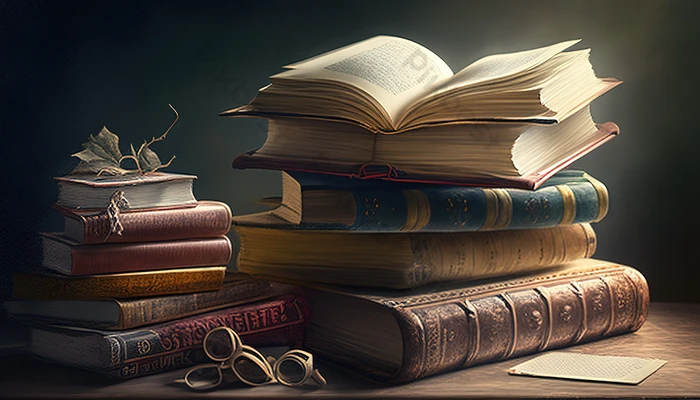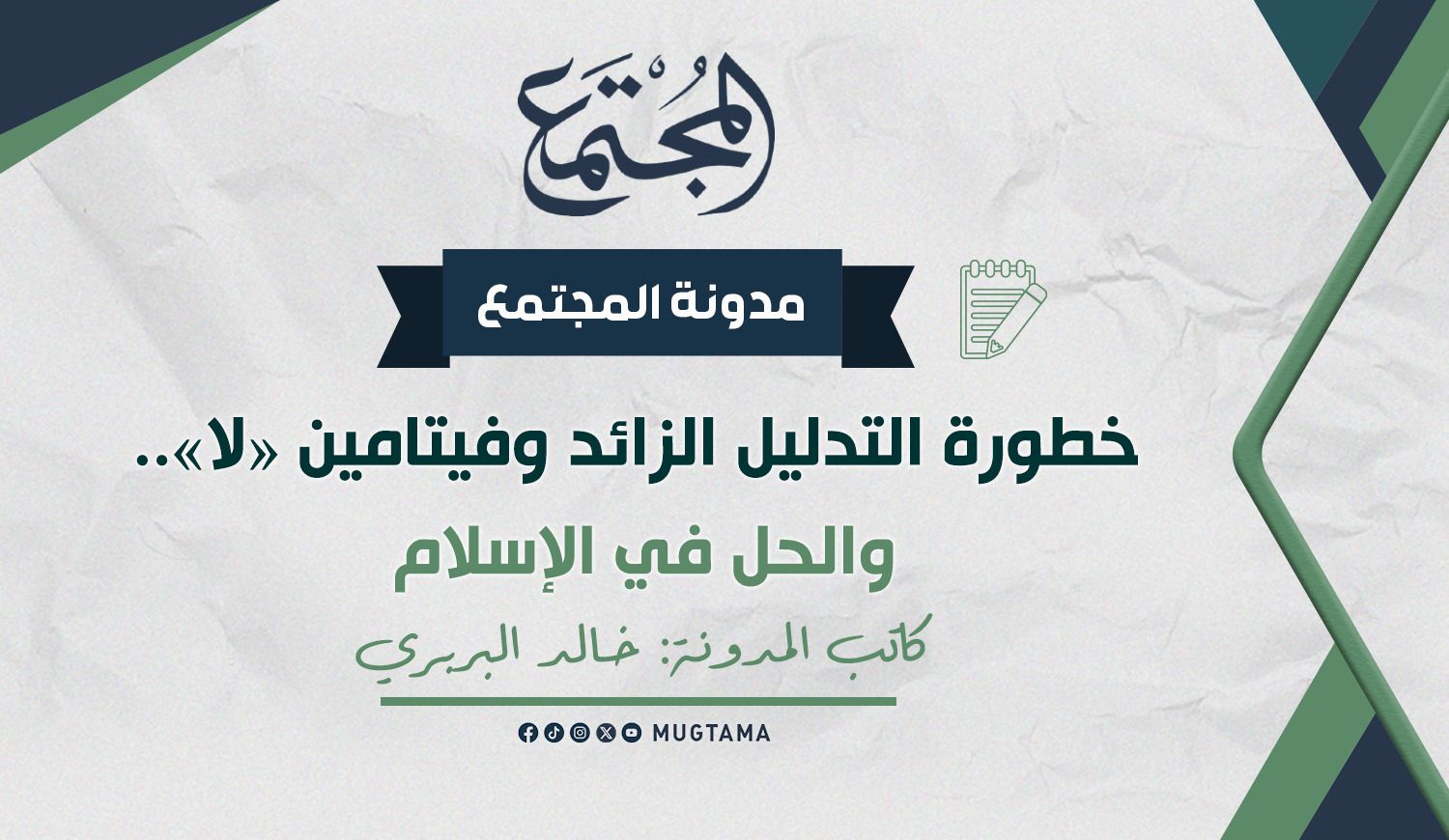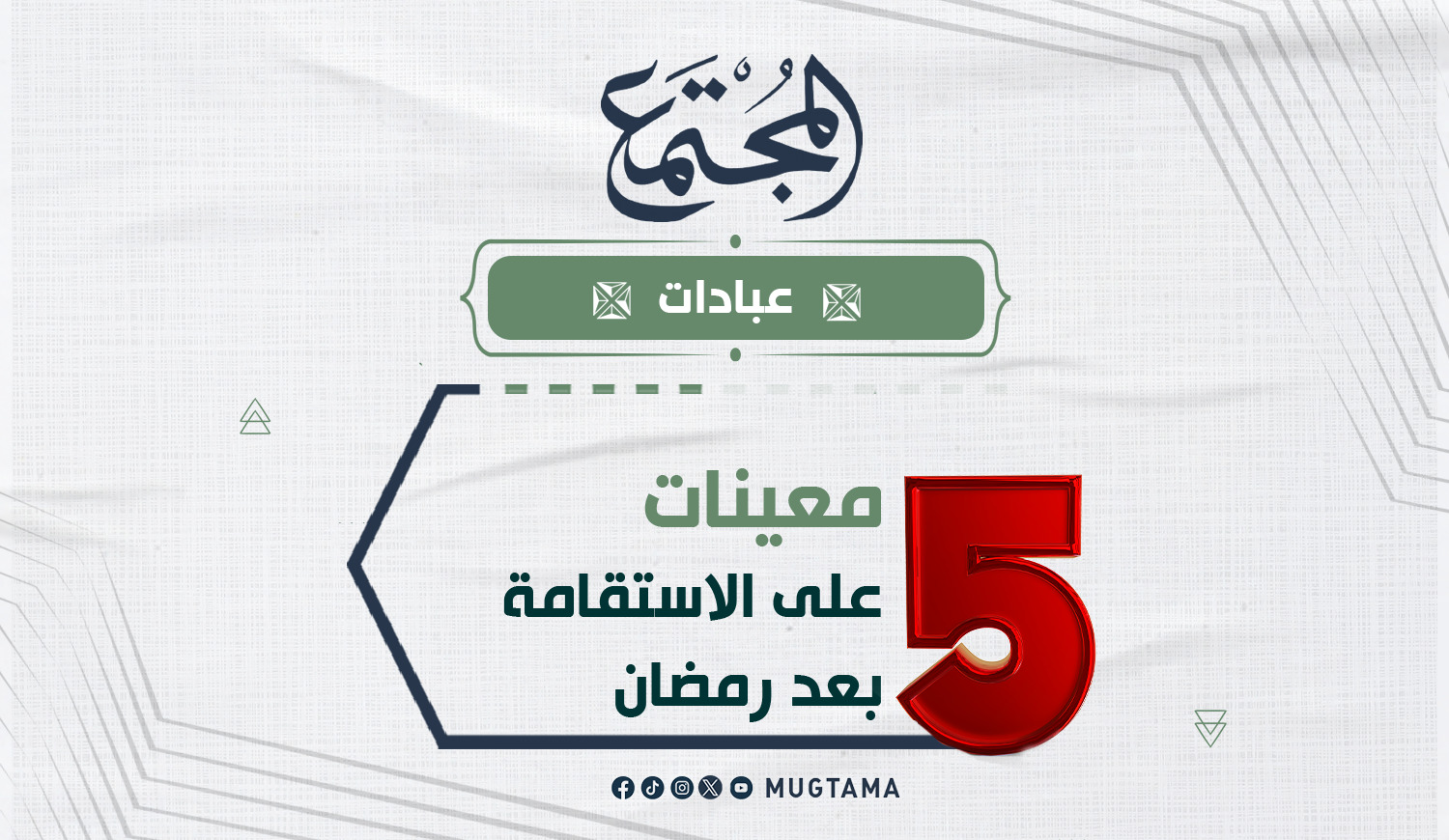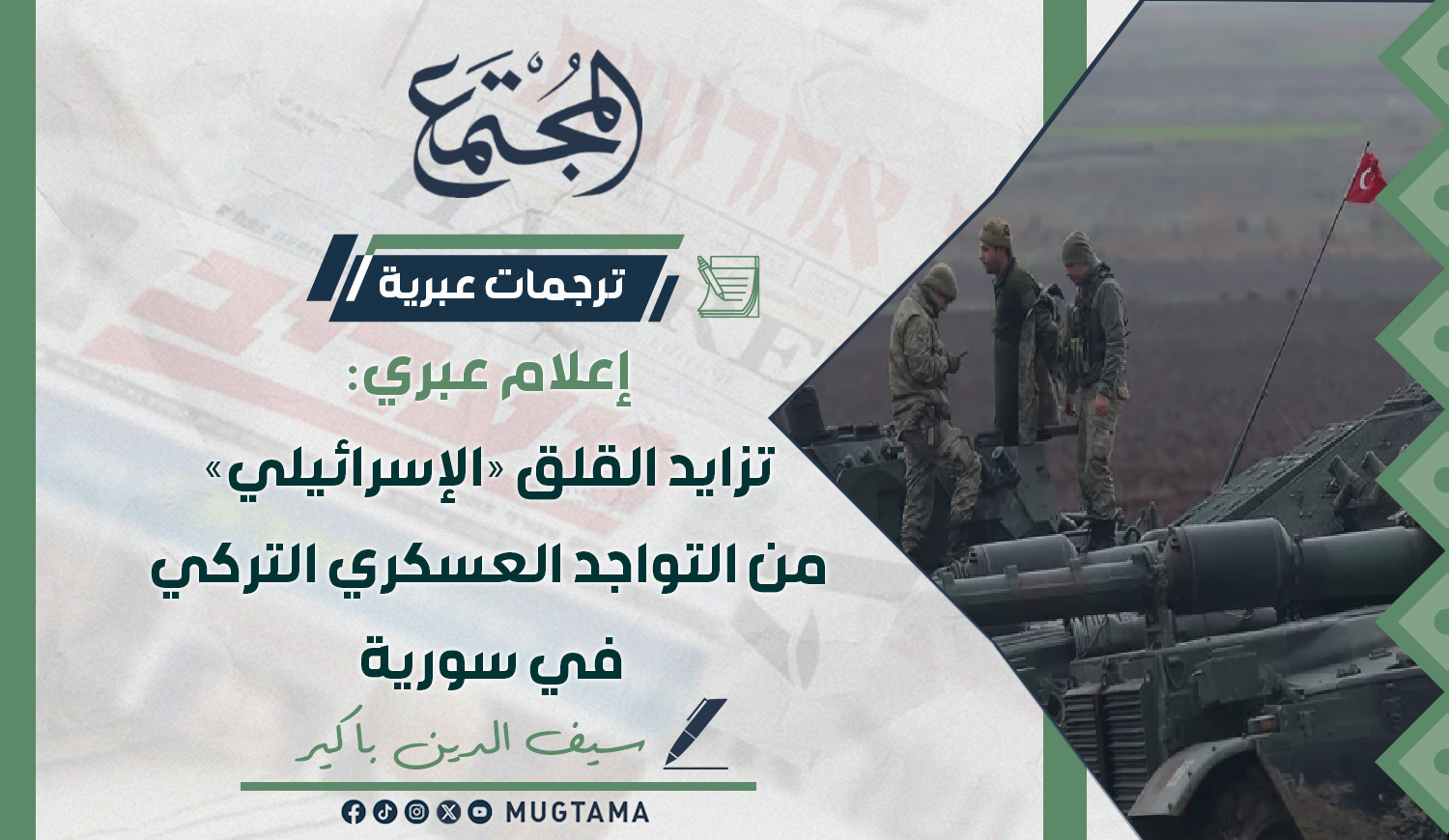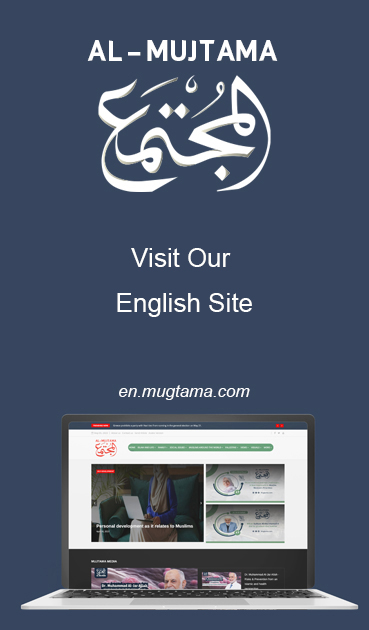نظرات في عمران المدينة المنورة زمن النبوة والراشدين

كانت قضية استيعاب
المهاجرين إلى المدينة من أهم ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم عقب
هجرته إليها، وقد بادر الأنصار إلى تقديم العون في ذلك، حيث جعلوا لرسول
الله "كل أرض لا يبلغها الماء، يصنع بها ما شاء"، وكذا "عفائن
الأرض" -وهي الأرض التي فسدت بطول تركها- وما كان من الخطط المسكونة العامرة؛
فإن الأنصار وهبوه له، فكان يقطع منه ما شاء. فتولد عن ذلك أراض كثيرة أقطع منها
النبي المهاجرين، وخطَّ الخطط، وجعل كل قبيلة في خطة ليحفظ
ما بينهم من ترابط اجتماعي، ويُذهب عنهم الشعور بالغربة في مهجرهم..
وامتدت من المسجد -وهو قلب
المدينة ومركزها- شوارع رئيسة تصله بجهات المدينة الأربع، وقامت منها شوارع فرعية تتوغل داخل خطط الأنصار والمهاجرين، لتسهل التوصل إلى مسجد الرسول في المركز(1).
وقد مر بنا أن
النبي أقطع بعض الصحابة أراضي واسعة لاستصلاحها والبناء عليها، منها إقطاعه
العقيق لبلال بن الحارث، ثم إنه عجز عن تعمير هذه الأرضين، فانتزعها منه عمر بن
الخطاب، وأقطعها غيره من المسلمين. وأرض العقيق تقع على مسافة غربي مسجد النبي،
فكان عمر حريصًا على مد العمران في هذه النواحي ليبتعد التركيز السكاني عن قلب
المدينة. وهو ما تحقق بالفعل، فنزل بنواحي العقيق جماعة من الصحابة منهم سعد بن
أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو هريرة وسعيد بن العاص، ومات فيها سعد بن أبي وقاص
وسعيد بن زيد وسعيد بن العاص، وحملوا إلى المدينة، فدفنوا بالبقيع.
وفي خلافة عثمان اتسعت
مساحة المدينة، وامتدت المنازل بها تملأ الفجوات الواسعة بين أحيائها، واتصل وسط
المدينة بأطرافها، وبلغ البناء جبل سلع في شمالها الغربي، وتجاوزه إلى منازل بجوار
مسجد القبلتين، واتصل ما بين قباء والعوالي في جنوبها، وامتدت المنازل إلى أطراف
وادي العقيق غربًا.
وباستقراء ما ورد عن بيوت
الصحابة في هذا العصر يمكن تقرير عدة تصورات:
1- بساطة هذه المباني،
وبخاصة في أوائل عصر الراشدين، تأثرًا ببساطة بيوت النبي، وإيثارًا للزهد،
وانشغالاً بأعباء الدعوة والجهاد.. فقد روى البخاري وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله
عنهما، قال: "رأيتني مع النبي بنيت بيدي بيتًا يكنُّنِي من المطر،
ويُظلُّني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله"، وعدم حاجته إلى من
يساعده دليل على بساطته وقلة كلفته.
2- وروى عمر بن شبة أن
عمار بن ياسر خرج إلى الشام مجاهدًا، فنزل بحمص، ثم كتب إلى عمر بن
الخطاب يذكر له أنه يريد الحج، وسأله أن يبني له داره بالمدينة قبل قدومه،
فبناها، وباشر عمر بناءها بنفسه، وربما ناول عمالها مكاتل الطين بيده، فقدم
عمار وقد فرغ من بنائها، فتعاظمها، واستوسعها، وقال: إنما كنت أريد ما يظل
رأسي، وأقيد فيه راحلتي حتى أرجع إلى مرابطي.
3- ثم توسعوا في بيوتهم
بعدما تحسنت أوضاعهم الاقتصادية، باستمرار الفتح، وانثيال الغنائم، فكان بعض
منازلهم متسعًا، بحيث يمكن قسمته إلى منزلين، فقد روى ابن شبة أيضًا أن الزبير بن
العوام كان له منزل في الجهة الغربية من المسجد، وقد قسمه بين ولديه عمر وعروة، ومنزل
طلحة بن عبيد الله في غربي المسجد أيضًا، وقد قسمه ثلاثة من أولاده بينهم بعد
مقتله في وقعة الجمل سنة 36هـ.
4- وكان عامة بيوت الصحابة من طابق واحد، لكن بعضها تكون من
طابقين، مثل دار أبي أيوب الأنصاري التي نزلها النبي بعد الهجرة، وسكن طابقها
العلوي. وبيت خالد بن الوليد الذي شكا ضيق منزله إلى رسول الله فقال له
النبي: "اتسع في السماء"، أي يبني طابقًا أعلى.
5- وامتلك بعض الصحابة أكثر
من منزل، وبخاصة من كان منهم موسرًا، كما نجد في حال أبي بكر الصديق الذي
اتخذ دارًا إلى زقاق العقيق، وثانية إلى جوار المسجد النبوي، وثالثة
بالسُّنح عند بني الحارث بن الخزرج، وكان لعثمان بن عفان منزلان شرقي
المسجد متصلان ببعضهما، أحدهما أكبر من الآخر، وكذا عبد الرحمن بن عوف، كان يمتلك
عدة دور، دخل منها ثلاثة في توسعة المسجد النبوي، والسيدة أم حبيبة زوج النبي،
التي اتخذت لها دارًا في شمال المسجد، فضلاً عن حجرتها ضمن حجرات أمهات المؤمنين،
بحسب رواية السمهودي، وكان للزبير بن العوام أحد عشر دارًا بالمدينة، وكان لأبي
رافع مولى النبي داران، باعهما لسعد بن أبي وقاص.
6- استمر منهج التكافل
الإسلامي بين الصحابة، فوهب بعض القادرين منهم منزلاً أو أكثر لذوي الحاجة من
الصحابة.. فقد وهبت أم حبيبة زوج النبي دارًا لها لشرحبيل بن حسنة، فكانت
تعرف بدار آل شرحبيل، وأعطت أم سلمة إحدى دورها إلى عمار بن ياسر، وأوقف خالد بن
الوليد داره بالمدينة، لا تباع، ولا توهب.
ومما يتصل بالفكر العمراني
آنذاك اتخاذ الكُنُف خارج النطاق السكاني، للتبرز؛ كراهية لاتخاذها في البيوت،
حرصًا على نظافتها وطيب رائحتها، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حديث
الإفك: "وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا"، وكانوا يسمون تلك
المواضع لقضاء الحاجة خارج البيوت "المناصع"، وهي "صعيد
أفيح"، أي متسع من الأرض، ويوصل إليها زقاق كان يسمى زقاق المناصع.
وكذلك العناية بنظافة
الشوارع والبيوت، لتكون مظهرًا منسجمًا مع ما أمر به الإسلام من النظافة والجمال،
فلما قدم عمر بن الخطاب مكة جعل يجتاز في سككها، فيقول لأهل المنازل: قُمُّوا
أفنيتكم..(2). بل أمر بذلك عماله على الأمصار، حيث
قَدِم أبو موسى الأشعري، رضِي الله عنه، إلى البصرة فقال لهم، فيما يرويه ابن أبي
شيبة في مصنفه: "إنَّ أمير المؤمنين بعثني إليكم، لأعلِّمكم سنَّتكم،
وإنظافكم طرقكم".
ولا يعقل أن يهمل عمر أمر
النظافة في المدينة المنورة، ويُعنى بها خارجها. فقد أتى مسجد قباء على فرس له، فصلى فيه، ثم قال لغلامه: يا يرفأ، آتني بجريدة (أي سعفة)، فأتاه بها، فاحتجز عمر ثوبه، ثم كنسه (رواه ابن أبي شيبة)، بل اشتهر أحد موالي عمر واسمه عبد
الله بالمُجَمِّر، لأنه كان يجمِّر المسجد (أي يطيبه بالبخور) إذا قعد عمر على
المنبر(3).
أما متنزهات المدينة وأماكن
الترويح عن النفس فيها فكان أبرزها الحدائق حول آبار المياه، ومنها وادي العقيق
إذا سال ماؤه.
من ذلك أنه لما كان عام الرمادة وانقضى،
وأمطرت، وسالت الأودية، خرج عمر مع بعض أصحابه إلى العقيق، ليشهدوا تدفق السيل من
بعد شدتهم(4).
(1) د. عثمان: المرجع نفسه ص 51.
(2) المتقي الهندي: كنز العمال 12/667.
(3) ابن عبد البر: التمهيد 16/177.
(4) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/141.