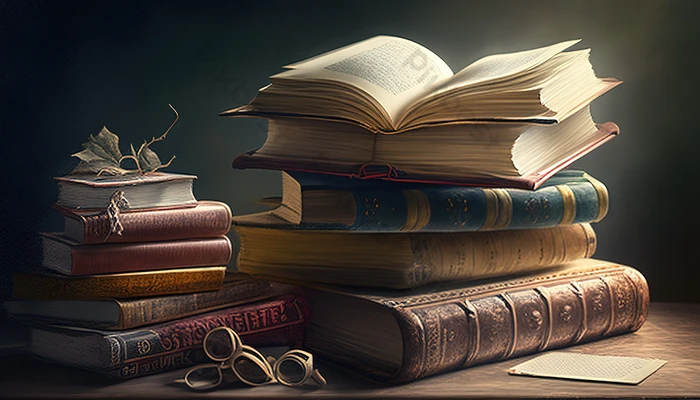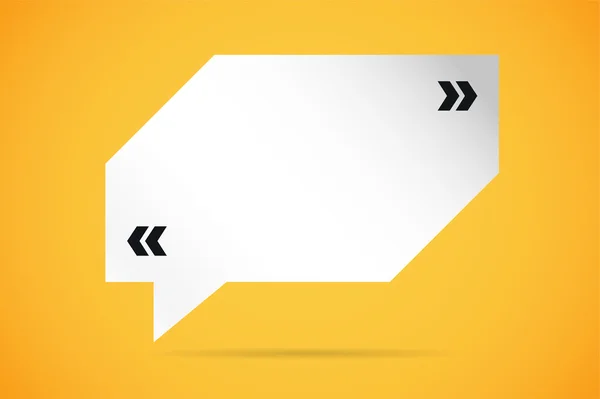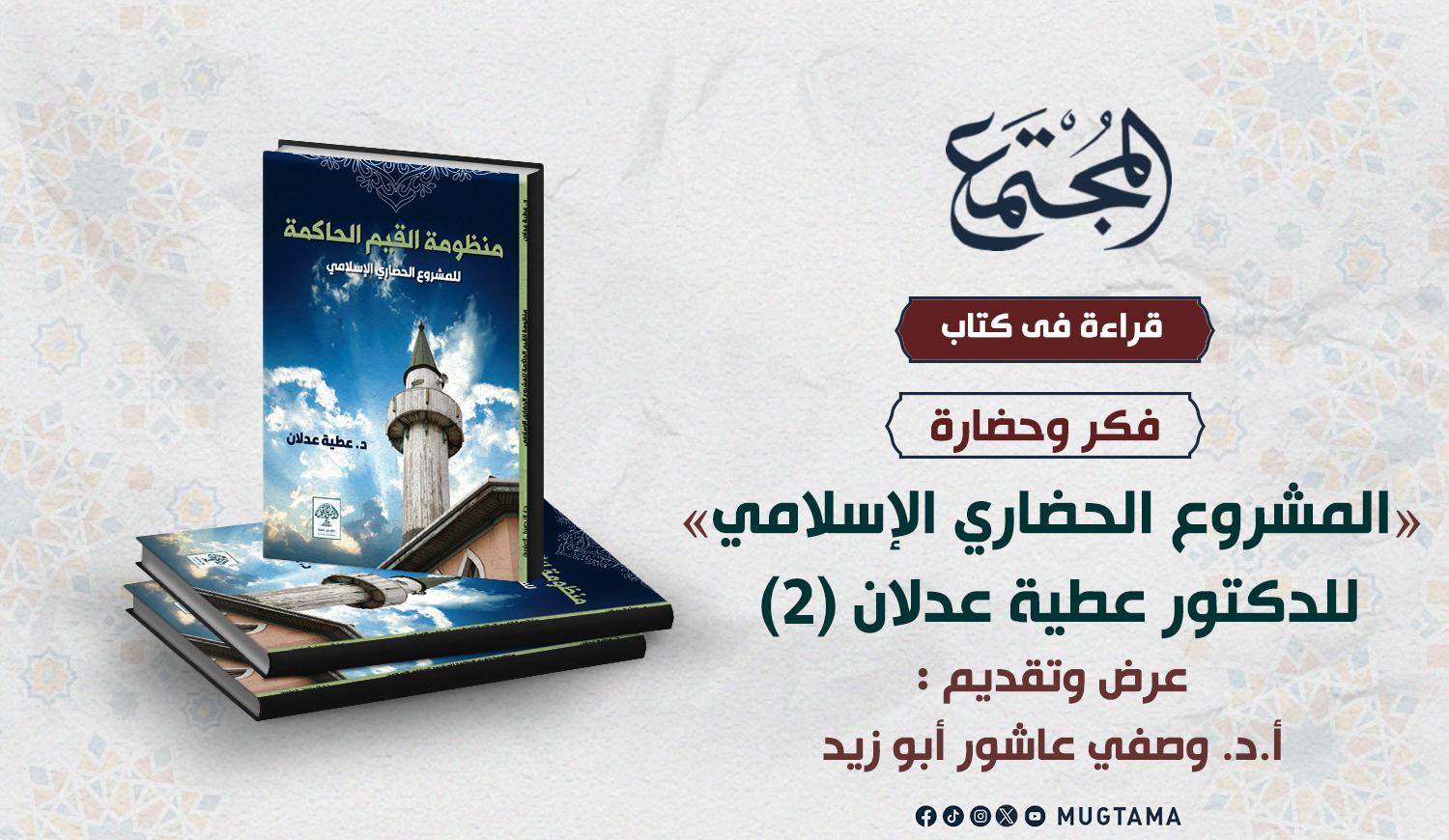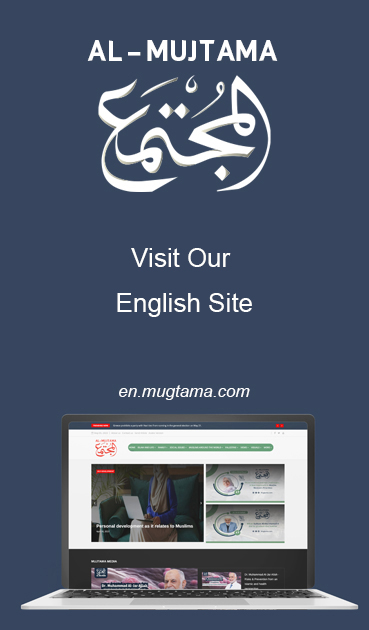عوائق في الطريق (19)
التَّشَدُد والمغالاة في الدين

شاء الله تبارك وتعالى أن يكون المنهج الإسلامي منهجاً وسطياً يتفق مع الفطرة التي خُلِق الإنسان عليها، وهي التوسط والاعتدال في كل شيء، قال تعالى: (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...) (البقرة:143)، فإذا انحرف المسلم عن هذا المنهج وقع في التشدد والمغالاة!
وقد أكد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رفضه لهذا العائق (التشدد والمغالاة في الدين) في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" (رواه البخاري)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لن يُنجِيَ أحدا منكم عملُه قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمَّدَني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدُّلْجَةِ والقصدَ القصدَ تبلغوا" (متفق عليه)، وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "هلك المُتَنَطِّعُونَ، قالها ثلاثا".
ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المنير عند شرحه لحديث البخاري "إن الدين يسر" قوله: قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة! (1)
تعريف التَّشَدُد والمغالاة في الدين
والتَّشَدُد والمُغالاة في الدِّينِ لغة: هو الارتفاع، أو الإفراط، ومجاوزة الحد أو القدر في كل شيء، تقول: غلا في الدين، وغلا في الأمر غلوا، جاوز حده، وفي التنزيل: (لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) (النساء:171) أي لا تفرطوا فيه، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال، أو حد التوسط (2).
والتَّشَدُد والمُغالاة في الدِّينِ عند علماء التربية: هو التعمق، أو الإفراط، أو مجاوزة الحد في الأقوال والأعمال، وبعبارة أخرى: هو تحميل الأقوال، أو الكلمات والأعمال فوق ما تحتمل، والتشدد بهذا المعنى يساوي التنطع، كما يساوي المغالاة في الدين.
مظاهر التَّشَدُد والمغالاة في الدين
مظاهر التَّشَدُدُ والمغالاة في الدين كثيرة، نذكر منها:
- تكلف المسلم من العبادات ما لا يستطيع
فيؤدي به ذلك إلى فوات الأفضل أو إلى السآمة، فيعيقه هذا عن السير في الطريق إلى الله، وذلك كمن يتكلف قيام الليل ويطيل فيه حتى يتعب من السهر، فتغلبه عيناه عن صلاة الفجر في الجماعة، أو عن أدائها في وقتها المختار أو الضروري.
- كثرة الافتراضات، والسؤال عما لم يقع
أو عما عفا الله تعالى عنه، وسكت، ولعل هذا هو بعض ما يؤخذ من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (المائدة:101).
- الأخذ بالعزيمة في موضوع الرخص
كمن يباح له التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فيترك التيمم، ويصر على استعمال الماء فيؤدي ذلك إلى ضرر في بدنه.
- الاشتغال بمسائل الفروع على حساب الأصول أو استفراغ الجهد في المختلف فيه، مع إهمال المتفق عليه، كمن يقضي وقته في قضية الجهر بالبسملة، أو الإسرار بها، وكذلك قضية موضع اليدين في الصلاة: هل على السرة، أو فوقها، أو تحتها؛ ويهمل الحديث عن تحكيم شرع الله تعالى في مناحي الحياة.
- التكفير بالمعصية، أو بالكبيرة
بل تكفير من لم يكفر الكافر، وكذلك جعل الأصل في الأشياء التحريم، مع أن القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما جاء النص بخلافه.
- إحياء الكلام في المسائل التي فرضتها ظروف معينة
ثم انتهت بانتهاء هذه الظروف، مثل الكلام في مسائل الصفات، وخلق القرآن، والخلاف الذي نجم بين الصحابة، ونحو ذلك (3).
عواقب التَّشَدُد والمغالاة في الدين
للتَّشَدُد والمغالاة في الدين عواقب خطيرة وآثار مهلكة على الفرد، والعمل الإسلامي، فعلى مستوى الفرد يؤدي إلى:
- كراهية الناس، ونفورهم من المتشدد والمغالي في الدين
وذلك لأنه واقف في الطرف بعيدا عن الوسط، فكرًا كان ذلك أو سلوكًا، ومثل هذا لا تحتمله الطبيعة البشرية، ولا تصبر عليه، ومن ثم تنفر منه وتكرهه.
- الفتور أو التوقف
وذلك أن التشدد والاستمرار عليه لا يتفق مع طبيعة الإنسان وطاقته المحدودة، فإن صبر يومًا على التشدد فسرعان ما يمل، ويسأم، ويدع العمل حتى القليل منه أو يأخذ طريقا آخر، على عكس الطريق الذي كان عليه، أي ينتقل من الإفراط إلى التفريط، ومن التشدد إلى التسيب، ولعل هذا هو بعض سر قوله صلى الله عليه وسلم: "اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل" (متفق عليه).
- إهمال حقوق الآخرين
وذلك أن المتشدد يدور في دائرة معينة من الفكر والسلوك، الأمر الذي ينتهي به إلى إهمال حقوق يجب أن تراعى، وواجبات ينبغي أن تؤدى، ولعل هذا هو سر قول سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: "إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه" (رواه البخاري).
- القلق والاضطراب النفسي
وذلك أن المتشدد في معظم أحواله يريد حمل الآخرين على ما يعتقده، وما يوافق هواه، وعندما يجد صدوداً من الآخرين وعدم استجابة، يصاب بالقلق، والاضطراب النفسي.
أما على مستوى العمل الإسلامي، فيؤدي التشدد إلى:
- الفرقة والتمزق
وذلك أن المتشددين لا يلتقون على رأي واحد، ولا يقبل الآخرون رأيهم، وحينئذ تكون الفرقة، ويكون التمزق.
- طول الطريق
وذلك أن التشدد مكروه ومنفر، الأمر الذي يعطي المتربصين بالعمل الإسلامي الفرصة لتوجيه الضربة بعد الضربة من أجل القضاء على هذا العمل أو على الأقل إجهاضه بحجة التشدد، أو التزمت، وحينئذ يطول الطريق.
- عدم كسب الأنصار
وذلك أن التشدد والغلو في الدين، يحول دون كسب الأنصار، فقد فطرت النفوس على حب الهين اللين، وعلى بغض الغليظ القاسي، وحسبنا هنا قوله تعالى في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) (آل عمران:159).
أسباب التَّشَدُد والمغالاة في الدين
للتَّشَدُد والمغالاة في الدين أسباب كثيرة نذكر منها:
- البيئة
فقد ينشأ المرء في بيئة اتخذت التشدد والمغالاة منهجًا لها، سواء أكانت بيئة قريبة، ونعني بها البيت، أم بيئة بعيدة، ونعني بها الأصدقاء، وليست لديه حصانة فكرية، فيحاول الاقتداء والتشبه بهم، وحينئذ يقع فيما وقعوا فيه من تشدد.
- تحصيل العلم من الكتب دون مربٍ
وقد تكون لدى المسلم الرغبة في تحصيل العلم، فيلجأ إلى الكتب، فتجنح به هذه الكتب نحو التشدد والمغالاة؛ نظرا لأن الكتب وجهات نظر صامتة، لا تعطيه القدرة على رد التساؤلات التي تثيرها قراءة هذه الكتب، أو التي يثيرها الواقع نفسه، بينما لو كان تحصيل هذا العلم، بواسطة مربٍ فإنه لسعة اطلاعه، وتجربته، وبصيرته النافذة يمكنه الرد على كل هذه التساؤلات، بل حتى على الشبهات إن وجدت.
- أخذ العلم عن الجاهلين
وقد تكون لدى المسلم الرغبة في تحصيل العلم؛ ولكنه لا يعرف على يد من يأخذ هذا العلم، وتلقي به الأقدار إلى الجلوس بين أيدي الجاهلين وتصير العاقبة الوقوع في التشدد والمغالاة في الدين.
- الحظوظ النفسية
وقد تكون الحظوظ النفسية من حب الشهرة، أو المغنم والجاه، من وراء الوقوع في التشدد، من منطلق أن التشدد يحمل في طياته غالبا كل شاذ وغريب، والشواذ والغرائب من بين ما يكسب الشهرة، والانتشار.
- الرغبة في تحقيق القرب من الله تعالى مع جهل معالم الطريق
ولعل هذا ما تؤكده هذه الرواية التي تقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي، صلى الله عليه وسلم، في السر، فلما أخبروا كأنهم تَقَالُّوهَا، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر؛ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا، وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (متفق عليه).
- كراهية الإسلام مع التظاهر بحبه
وقد تكون الكراهية للإسلام مع التظاهر بحبه وراء الوقوع في آفة التشدد، على نحو ما وقع من عبد الله بن سبأ اليهودي، ومغالاته في شأن عليٍّ رضي الله عنه، من أنه حل في الإله، أو هو الإله، وأنه لم يمت، وإنما رُفع إلى السماء، وأن الرعد صوته، والبرق نوره وسناؤه، وما تبع ذلك من الغلو في شأن الأئمة، وادعاء العصمة لهم.
- نسيان العواقب المترتبة على التشدد والمغالاة في الدين
حيث إن الإنسان إذا نسي عاقبة الشيء تجرأ على فعله، وإن كان فيه حتفه وهلاكه.
علاج التَّشَدُد والمغالاة في الدين
على كل من أراد أن ينقذ نفسه من الوقوع في عائق "التَّشَدُد والمغالاة في الدين" اتباع الخطوات التالية:
1- الحرص على أخذ العلم على يد العلماء العاملين المتبصرين بفقه الدين والواقع.
2- التبصر بفقه العبودية، والدعوة إلى الله، والفتوى، من ترتيب الأولويات، ومن معرفة بمقاصد الشريعة، وكلياتها، ومن فهم للنصوص في ضوء بعضها البعض، ومن إلمام بمراتب الأحكام، وطريق ثبوتها، والعلاقة بينها عند التعارض، ومن رعاية لأدب الخلاف، وعن العلم بقيم الأعمال، ومراتبها، ومراتب المأمورات، والمنهيات، بل مراتب الناس مع الأعمال، وتقدير ظروف الناس، وأعذارهم، ومن الإلمام بسنن الله في خلقه (الكونية منها، والشرعية)، ولا سيما سنن وشروط النصر، فإن هذا التبصير كاف في القضاء على التشدد والمغالاة في الدين.
3 - دوام النظر في التاريخ البشري بعامة، والإسلامي بخاصة، فإن هذا التاريخ حافل بالنماذج الحية من المتشددين والمغالين في الدين والآثار السيئة التي جناها هؤلاء من وراء تشددهم، وهي حافلة كذلك بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها.
4- معرفة الآثار والعواقب المترتبة على التشدد، سواء منها على العاملين، أو على العمل الإسلامي، فلعل ذلك يساعد في التخلص من هذه الآفة، ومجاهدة النفس لئلا تبتلى بها مرة أخرى.
5- شغل أوقات الفراغ بالنافع المفيد من خلال وضع وتنفيذ برامج تعليمية وإعلامية، وترفيهية، وتدريبية، بحيث تتجاوب هذه مع الفطرة ولا تتعارض مع شرع الله تعالى، مع الابتعاد عن بيئة التشدد القريبة والبعيدة (4).
(1) - فتح الباري - ابن حجر – 1/87.
(2) - النهاية في غريب الحديث والأثر – ابن الأثير – 3/169، بتصرف.
(3) - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث – الشيخ محمد الغزالي – 1/7-12، بتصرف.
(4) - آفات على الطريق – أ.د/ السيد محمد نوح – 3/153، بتصرف.